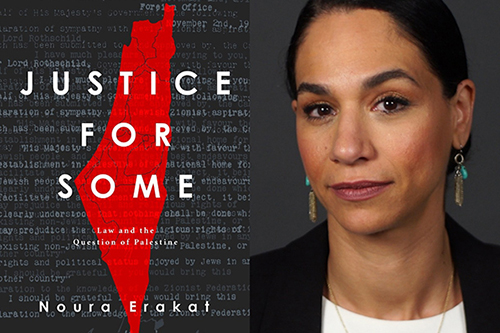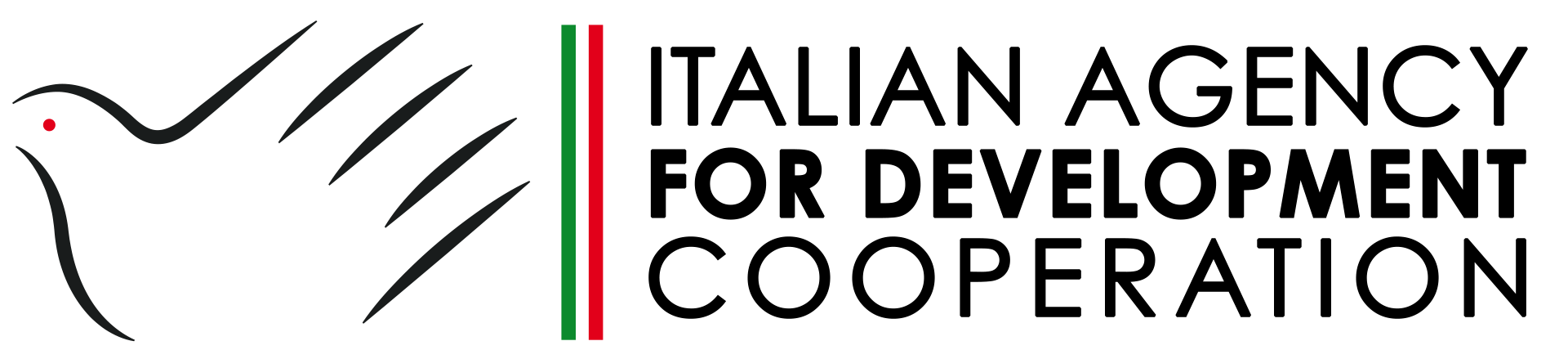"مجلة جنى" عندما قرّر الأرقش أن يذبح حبيبته ليلة زفافهما، فإنما كان بذلك يضع حدّاً، ليس لمأساةٍ داخلية جوانية، تتصل بشخصه الإنساني، الوجودي، العقلي، والفكري، وتلخّص الصراع الذي كان ينتابه حيال قيم حياته ومعاييرها، وخصوصاً من خلال التجاذبات القائمة بين جسده وروحه، وإنما كان يضع حدّاً لمأساةٍ تتصل بالوجود البشري مطلقاً. من هذه الزاوية بالذات، أرغب في أن ألقي الضوء على ميخائيل نعيمة، صاحب كتاب "مذكرات الأرقش" (1949) وثلاثية "سبعون" (1959-1960)، في الذكرى الثلاثين لرحيل هذا المفكر والكاتب والشاعر والناقد اللبناني الكبير (28 شباط 1988)، الذي كان مع جبران والريحاني، أحد المؤسسين الكبار الذين أرسوا المداميك العميقة للنهضة الأدبية والفكرية، اللبنانية والعربية الحديثة. "دار نوفل" (هاشيت أنطوان) أعادت طبع مؤلفاته كلها.

من الصعب الإحاطة بالجوانب المتنوعة لشخصية ميخائيل نعيمة، وإن تكن فلسفة الوجود والأنسنة تمثّل بعداً جوهرياً في مشاغل هذه الشخصية وهواجسها. ملاحقة هذا البعد، يمكن استشفاف مكوّناته وخصائصه في كلّ اهتماماته وتجاربه، الروائية والقصصية والسردية والتذكرية والشعرية والنقدية والفكرية. فهو كان فيلسوفاً مفكراً أديباً روائياً قاصاً شاعراً وناقداً في الآن نفسه، ومن الإجحاف فصل باب من هذه الأبواب عن أشقائه وشقيقاته، لاستخلاص العبرة الجامعة منه؛ فهي كلّها متناسقة، منسجمة، متآلفة، متكافلة، متضامنة، حتى لتبدو أنها قوامٌ أدبي - فلسفي متكامل، لا تجوز تجزئة عناصره، أو استبعاد أحدها، لدى معاينة عنصر آخر.
الصراع بين الأرض والسماء، بين الجسد والروح، بين الهنا والهناك، هو خلاصة فلسفته التي جسّدها في "مذكرات الأرقش"، كما في ثلاثيته "سبعون". وهو عندما جعل بطله الأرقش، الشابّ الأرجنتينيّ المثقّف من أصل لبنانيّ (ميخائيل نعيمة نفسه!؟) يطلق صرخته المدوية، المعبَّر عنها بهذه الجملة التي حملتها وريقةٌ صغيرة تركها على فراش حبيبته، "ذبحتُ حبّي بيدي لأنّه فوق ما يتحمّله جسدي ودون ما تشتاقه روحي"، فإنما كان بذلك يعبّر تمام التعبير عما يتنازع النفس البشرية المصلوبة بين قطبين، الجسد والروح.
لكن، هل القضاء على أحد هذين القطبين هو الحل؟ هل هما نقيضان، أم هما طرفا الجدلية اللذان لا بدّ من العثور على سرّ التكامل والمواءمة بينهما، وهذا ما لم يتمكن نعيمة من الوصول اليه بنفسه عبر بطله الأرقش؟ وهل التصوف، أو النسك، أو الهرب، أو الاستقالة من المواجهة، أو التقمص، أو الحلولية، أو سوى ذلك من التصورات، هو الحلّ، أو هو وهم الحلّ؟!
كان الأرقش يعتبر "الزواج مقبرة الحبّ" ويرى أن "الحبّ يسمو بالمحبّ الى أعلى والزواج يشدّ به الى أسفل"، وأن هذا الحبّ "يلتهم المحبّ فينشره شعاعاً في الفضاء والزواج يسجن المحبّ فينثره هباء في الهواء". ففي رأيه أن "الحبّ ذوبان فتبخر فانعتاق، والزواج تمجد فتصدع فانشقاق". لذا كان عليه أن يضع حداً للزواج، فارتأى أن يذبح حبيبته (!) وأن يتسبب لنفسه بفقدان الذاكرة، وأن لا يعرف من ماضيه وحاضره سوى أنه خادم في مطعم سوري بمدينة نيويورك، يأوي إلى تخشيبة ليكتب مذكراته.

لكن، ما الذي كانت تصبو إليه الروح، روح نعيمة، أو روح قناعه الأرقش؟ هل كانت تصبو إلى الحلولية في الله؟ وإذا كانت تصبو إليه، فهل الحبّ الأرضي، الجسدي، يحول دون هذا الارتقاء التوحدي بالله؟ ترى، ألهذا السبب قرّر أن يكون ناسكاً في النهاية، وأن يحطّ الرحال بعد طول تجوال، عائداً إلى بسكنتاه، وصنّينه، بانياً صومعته هناك في العزلة الروحية والمكانية، مكتفياً بكونه "ناسك الشخروب"؟
قيل الكثير عنه أديباً وقاصاً وروائياً وناقداً، وعضواً في "الرابطة القلمية"، لكن ينبغي لنا أن نعود إلى تلك الحقبة التاريخية والأدبية والفكرية نفسها، الحقبة الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر إلى العشرينات أو الثلاثينات من القرن العشرين، التي شهدت ولادة نعيمة، والحرب العالمية الأولى، وانتشار القتل والحقد والعداوة والبغضاء والتيه بين البشر، وسفره إلى موسكو فالولايات المتحدة، وانكبابه على تلقّف المعرفة هناك وهنالك، وتشرّبه من ينبوعَي الفكر والأدب الروسيين والأميركيين، والتعبير عن ذلك كله إما بالكتابة الأدبية الشخصية والفكرية العامة، وإما من خلال بلورة المواقف، بالمشاركة في تأسيس "الرابطة القلمية"، وإطلاق الأفكار والآراء فيها، باعتبارها منصة غير مسبوقة في احتضان المفاهيم والأسئلة والنقاشات التي كان الربع الأول من القرن العشرين يضجّ بها، ويهجس بتحدياتها.
الشغل الشاغل لدى نعيمة كان الإنسان، باعتباره مأوى القيم. هكذا بقدر ما ينشغل الأدباء ونقّاد الأدب بأدبه، وبـ"الرابطة القلمية" ودورها التاريخي الحاسم في النهضة الأدبية، يهمّني بالقوة نفسها، التركيز على مفهوم الحبّ عنده، مثلما يهمّني تظهير موقفه السلبي من الشقاقات والخلافات بين الناس، ومن الحرب مطلقاً، ومن الكارثة التي تصيب النفس البشرية من جرّائها، وخصوصاً أن التاريخ يكاد يعيد نفسه، وأن الإنسان يعيد تمثيل المأساة نفسها، من دون أن يتعظ. أليس العرب المشرقيون، ولبنان، واللبنانيون، يعيدون تجسيد مآسي التاريخ، الآن، وهنا، وإن بأشكال مختلفة؟
فلننظر ماذا يقول في الحرب: "شرّ الحرب الأكبر هو في قتلها الروح قبل الجسد، بتحويلها قوى الإنسان من عدوّ في نفسه إلى عدوّ خارج عنه"، و"من سيئات الحرب أنها تُجلس البطولة الزائفة على عرض البطولة الحقة فتدعو الذي يقهر أخاه الإنسان بطلاً وتبالغ في تمجيده وتكريمه، والذي يقاهر نفسه ليحسن معاملة أخيه الانسان تدعوه جباناً وتنبذه نبذ النواة". وكم أتذكر قصيدته، "أخي"، التي مطلعها "أخي إن ضجّ بعد الحرب غربيٌّ بأعماله/ وقدّس ذكرى من ماتوا وعظّم بطش أبطاله"، فهي تختصر هاجس الأنسنة عنده، بتقديمه على كلّ اعتبار آخر، رائياً أن الانقسامات بين البشر تمثل ذروة المأساة، وترمز إلى سقوط الإنسان في مستنقع الكراهة والحقد: "لله ما أسرع الناس في خلق أسباب الشقاق، وما ابطأهم في خلق أسباب الوفاق! وهل من شيء في عالم الناس لم يكن يوماً من الأيام مدعاة للخصام بين اثنين أو أكثر؟ ولعل أغرب ما في شؤون الناس ادعاؤهم أنهم يختصمون على الحق".
هذا الإدراك الرؤيوي القاتم للحقيقة البشرية، ولسقوط الانسان في فخّ الوجود الكاره ذاته، رافق نعيمة طوال حياته التي قاربت القرن إلاّ سنة واحدة، وجعلت أدبه وفكره يمتازان بالدعوة إلى الزهد والترفع، طلباً للأخوّة بين البشر، وللسموّ الروحي، والاقتراب من الله، تأملاً وتفكراً وتصوفاً، وترويجاً لفلسفة الأنسنة، وهو القائل في شأن الانقسامات بين البشر من حيث الانتماء إلى الأديان: "لو ان البشر عرفوا الله لما قسموه الى عبراني ومسيحي وبوذي ووثني وما انقسم البشر مللاً ونحلاً الا لأنهم حاولوا المستحيل فحدّدوا الله الذي لا يحدّ بلغاتهم المحدودة وقاسوا ما لا يقاس بمقاييس بشرية أرضية"، معبّراً عن شفقته حيال المطامع التي تسيطر على عقول البشر ونفوسهم: "إني لأشفق على الذين يسابقون الزمان فإذا بهم ما يبرحون حيث هم. وأحق منهم بالشفقة أولئك الذين يمتطيهم الزمان وما يفتأون يرددون: الوقت من ذهب فيا لثقل ما يحملون".
ولد ميخائيل نعيمة في بسكنتا في تشرين الأول1889 ، درس في مدرسة الجمعية الفلسطينية، وسافر إلى روسيا حيث تسنّى له الاطلاع على مؤلّفات الأدب الروسي، ثم أكمل دراسة الحقوق في الولايات المتحدة الأميركية منذ كانون الأول 1911. انضم إلى" الرابطة القلمية" التي أسّسها أدباءٌ عرب في المهجر وكان نائباً لجبران خليل جبران فيها. عاد إلى بسكنتا في العام 1932. لقّب بـ"ناسك الشخروب"، وتوفي في شباط 1988. من أعماله: "سنتها الجديدة" 1914، "الآباء والبنون" 1917، "الغربال" 1923، "كان ما كان" 1932، "جبران خليل جبران" 1936، "همس الجفون" عُرِّبت في العام 1945، "زاد المعاد" 1945، "البيادر" 1946، "صوت العالم" 1949، "مرداد" 1952، "النور والديجور" 1953، "في مهبّ الريح" 1957، "أبو بطة" 1958، "أبعد من موسكو ومن واشنطن" 1963، "اليوم الأخير" 1965، "هوامش" 1972، "في الغربال الجديد" 1973، "مقالات متفرقة، يا بن آدم، نجوى الغروب" 1974. "رسائل، من وحي المسيح" 1977...
في عزّ الحرب اللبنانية، زرته لمرةٍ يتيمة، في بيت إقامته في الزلقا، وكانت السيجارة في يده وإلى فمه، وفنجان القهوة على الطاولة. الآن، في الذكرى الثلاثين لغيابه، تعود تلك الصورة، صورته، بقوة، ووضوح، لتثير الأسئلة حول أدبه وفكره: أيكون صحيحاً أن الزواج هو مقبرة الحبّ، وأن الحرب هي مقبرة الوجود، وأن الإنسان خطأ "كوني"، وأن لا حلّ للبشرية إلاّ بالرفش والمعول لدفن الموتى... والأحياء؟!
المصدر: النهار