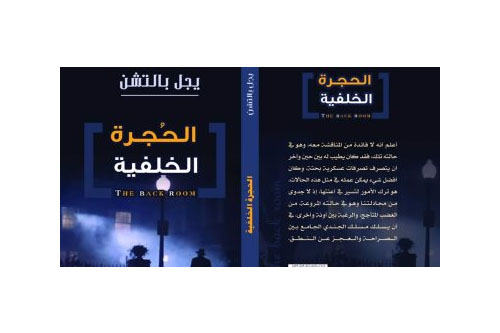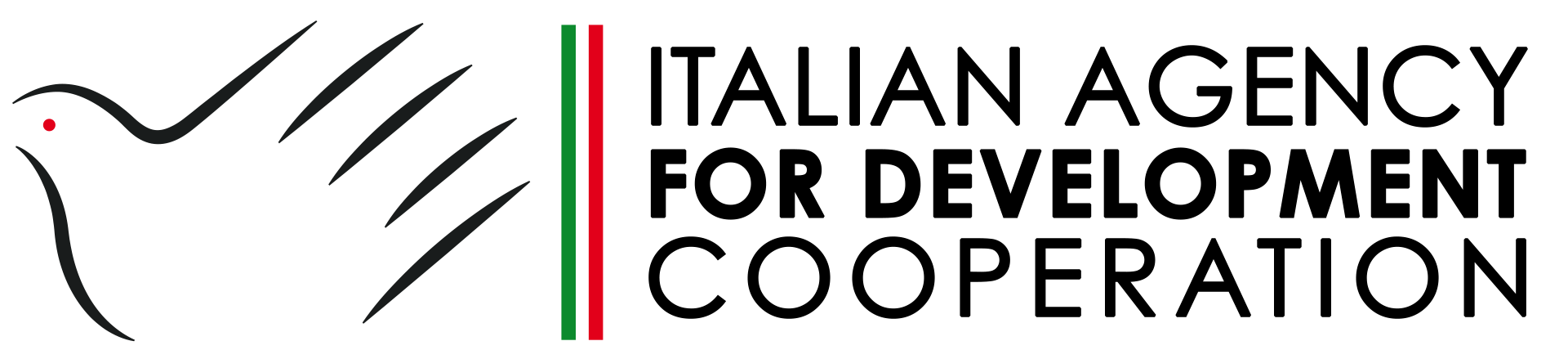"مجلة جنى" رحلت ريم بنّا عن عالمنا بعمر الواحدة والخمسين، وقد حلّ موتها في الرابع والعشرين من آذار (مارس) [المحرّر: الماضي]، بعد صراع مع السرطان استمرّ عشر سنوات، تاركًا ألمًا مُمِضًّا في قلوب الفلسطينيّين في كلّ مكان. لقد وحّدت ريم، الفلسطينيّة المسيحيّة من الناصرة، الفلسطينيّين على طول خطوط الانقسام السياسيّة والجغرافيّة.
عندما كانت تغنّي لوطنها، لم يكن لصوت أن يعلو إلّا صوت فلسطين، وعلى صوتها، كان المسيحيّون والمسلمون، فتح وحماس، غزّة ورام الله، يصبحون كلّهم جسدًا واحدًا.
بصوتها العاطفيّ والدافئ، كانت ريم قادرة على نقل الحزن والألم، مع احتفاء لا يخبو بالحياة، وقد مثّلت أغانيها، "فارس عودة" و"سارة"، تأويلًا شعريًّا لحياة الفلسطينيّين اليانعة التي قطفها الجنود الإسرائيليّون قبل نضجها.
"ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمةٍ
ستجري بك الغزالة إلى جوف جمّيزةٍ
ستحملك رائحة الخبز والحليبِ
شهيدًا إلى حضن أمِّكَ
قالت له النجمةُ:
خذني إلى صحن داري
خذني إلى فراش نومي
لقد تسلّق النعاس أطرافي
وتربّع في جوف رأسي".
تنجح الموسيقى في توحيد الفلسطينيّين عندما يفشل السياسيّون في ذلك. في الحقيقة، بينما ذهبت الدعوات المتكرّرة لـ "وحدة الفلسطينيّين" أدراج الرياح، استمرّت الموسيقى الفلسطينيّة في تقريب الفلسطينيّين من بعضهم.
إنّ الثقافة الفلسطينيّة، ذات الجذور العميقة، ما يجعل الفلسطينيّين ما هم عليه، شعبًا ذا هويّة فريدة وواضحة، على الرغم من سبعين سنة من التهجير، والنفي، والتطهير العرقيّ، والحصار، والحواجز التي لا تُحصى، والقتل الوحشيّ.
عندما تغنّي ريم، ينبعث صوتها ليخترق جدار الفصل، الذي يبدو منيعًا، ويعبر فوق نقاط التفتيش، وحظر التجوال العسكريّ، والمسافات التي لا تكاد تتصل.
لقد تمكّنت ريم من دخول قلوب وبيوت العديد من الفلسطينيّين خلال الانتفاضة الأولى عام 1987؛ بدايةً في فلسطين، وأخيرًا في كلّ مكان في العالم. فصوتها الناعم والمطمئنّ كان يمنح الأمل لمن عاشوا سبع سنوات طويلة من الحملة العسكريّة الإسرائيليّة القاسية والشرسة. لقد كانت التكتيكات الإسرائيليّة حينها تهدف إلى كسر روح الثورة والنضال بين الفلسطينيّين.
قدّمت موسيقى ريم أداء حديثًا وجديدًا للأغاني الفلسطينيّة التقليديّة، لكن من دون أن تتخلّى عن الهويّة التاريخيّة والثقافيّة لهذه الموسيقى.
تنتمي موسيقاها إلى نوع الموسيقى الفلسطينيّة ذات الباعث الوطنيّ، وإلى الفنّ المتمركز حول الثقافة، بهدف إعادة تقديم – وأحيانًا إعادة ابتكار – الماضي في صورة أكثر معاصرة وحيويّة.
بينما تعمل إسرائيل جاهدة لإنكار الثقافة الفلسطينيّة ومحوها، فإنّ الأيقونات الثقافيّة من أمثال ريم بنّا، بالإضافة إلى ريم كيلاني، وكاميليا جبران، وشادية منصور، وغيرهنّ، تعمل على إعادة التأكيد على الثقافة الفلسطينيّة، والهويّة بالتالي، في كلّ أنحاء العالم.
على الرغم من ضعف رواج هذا الشكل من المقاومة، فإنّ المقاومة الثقافيّة تقف في قلب النضال الفلسطينيّ في سبيل الحرّيّة.
لقد نبّهنا المفكّر الإيطاليّ، أنطونيو غرامشي، الذي قضى جلّ حياته في سجون الفاشيّة الإيطاليّة بسبب أفكاره عن المقاومة الثقافيّة، إلى أنّ الهيمنة الثقافيّة عدوّ لا يقلّ ضراوة عن الديكتاتوريّة الفجّة الصريحة.

أنطونيو غرامشي (1891 - 1937)
يواجه الفلسطينيّون الهيمنة الثقافيّة، لا على المستوى الأكاديميّ، بل على مستوى الواقع اليوميّ المعيش.
لقد أنفقت إسرائيل عقودًا من الزمن في شنّ حربها الثقافيّة ضدّ الفلسطينيّين، بهدف محو الثقافة الفلسطينيّة من جهة، وفرض بدائلها الثقافيّة من جهة أخرى.
وفي مفارقة غرائبيّة، فإنّ كلّ ما تسوّقه إسرائيل على أنّه ثقافة إسرائيليّة، هو في الحقيقة ثقافة عربيّة وفلسطينيّة تمتدّ لآلاف السنين؛ بداية من الطعام، ووصولًا إلى الموسيقى والأزياء، ومرورًا بكلّ ما يقع بينهما، عملت إسرائيل على سرقة الطابع الفلسطينيّ والعربيّ، وأعادت إنتاجه وتصديره باسمها.
لكن، على خلاف الحرب العسكريّة والسياسيّة، فإنّ الحرب الثقافيّة غالبًا ما تكون لا مرئيّة وتدريجيّة؛ فبينما تنشغل الحكومة الإسرائيليّة الآن باستبدال أسماء الشوارع العربيّة بأخرى عبريّة، وتعمل على منع إحياء ذكرى النكبة - الكارثة التي حلّت بالدمار على أرض الفلسطينيّين خلال 1947 - 1948 - فإنّها تهدف إلى كسر وحدة الثقافة الفلسطينيّة.
تاريخيًّا، روّج الصهاينة الفكرة الخاطئة بأنّ فلسطين أرض بلا شعب، وبأنّ السكّان المحلّيّين في هذه الأرض ليسوا إلّا مجموعات من البدو الرحّل، الذين لا تربطهم بالأرض أيّ جذور ثقافيّة ولا هويّة، لذا فإنّهم شعب لا يمتلك طموحًا سياسيًّا جماعيًّا.
لقد كانت هذه البروباجندا أساسيّة لترويج فكرة الدولة اليهوديّة في فلسطين، لكن سرعان ما اتّضح بأنّ هؤلاء "البدو" الموجودين في فلسطين قد تحوّلوا إلى "أزمة لاجئين". وحتّى هذا اليوم، لا يزال الصهاينة وداعموهم من اليمين يصرّون على الفكرة السمجة بأنّ الفلسطينيّين "شعب مُخْتَرَع".
لذلك، عندما تحتفي ريم بنّا، وريم الكيلاني، ومحمّد عسّاف، وعشرات غيرهم – ومعهم جمهرة من الشعراء والفنّانين والمناضلين الثقافيّين – بتقاليد شعبهم وموسيقاه وثقافته، فإنّهم بذلك يقفون على خطّ المواجهة أمام الخطاب الصهيونيّ العنيف، الذي التزم طيلة قرن من الزمن بالمحو الشامل لفلسطين.

محمّد عسّاف، وكاميليا جبران، وريم الكيلاني، وشادية منصور
بموسيقاها، حاربت ريم بنّا محاولة إسرائيل سلب ثقافة الشعب الفلسطينيّ، عندما أنسنت شخصيّات مثل فارس وسارة، وغيرهما الكثير.
لهذا السبب، ذرف الكثير من الفلسطينيّين الدموع في وداع ريم بنّا؛ ولهذا السبب أيضًا، ذرف الملايين دموع الفرح عندما فاز محمّد عسّاف – اللاجئ من غزّة – بلقب "عرب آيدول" عام 2013.
لم يكن الأمر متعلّقًا بأنّ محمّد عسّاف يمتلك صوتًا جميلًا وأنّه يستحقّ الفوز فحسب، إنّما بأنّه يمثّل ذلك الصوت العارم المؤكّد للذات، بصوته، وبكلماته، وبشخصه أيضًا.
فعسّاف لاجئ غزّيّ، شُرّدت عائلته من فلسطين التاريخيّة خلال التطهير العرقيّ العنيف الذي قامت به الحملات الصهيونيّة خلال 1947 - 1948. وُلد في الشتات وعاد في النهاية إلى غزّة، فقط ليعيش في ظلّ الحصار الإسرائيليّ المحكَم، وقد كسر الحصار ليشارك في المنافسة.
عندما غنّى عسّاف، سمع الملايين بذهول صوته، ورأوه وهو يكسر الجدران، ويطهّر الأرض من الحواجز ونقاط التفتيش. فجأة، باتت غزّة، ورام الله، والناصرة، وحيفا، موحّدة من جديد، عاد اللاجئون من شتاتهم واتّحدت البلاد مرّة أخرى.
بالمثل، كانت ريم تعبيرًا متعدّد المستويات، استبدلت السياسة والجغرافيا بعالم تتألّف فيه الأمّة الفلسطينيّة من ثقافة واحدة، وآلام مشتركة، ومن مقاومة وشعريّة وأمل لا يخبو.
ماتت ريم، لكنّ جيل الفنّانين الذي غذّته بتؤدة ومثابرة سيستمرّ بالغناء، احتفالًا واحتفاءً بالثقافة والحضارة التي لا يمكن إخضاعها بالبنادق أو حبسها بين الجداران.
لقد كانت ريم بنّا صوت فلسطين الذي لا يمكن إسكاته أبدًا.
المصدر: فُسحة