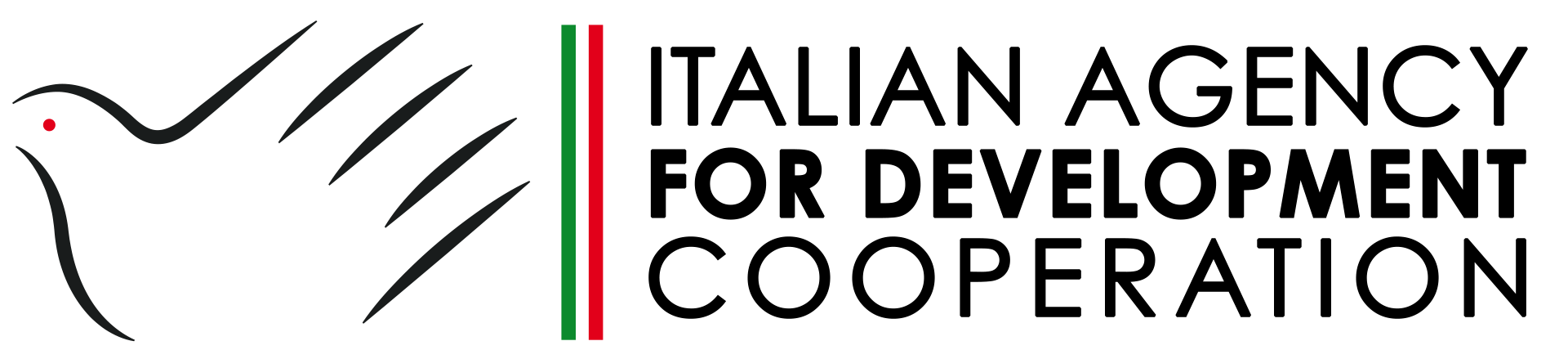"مجلة جنى" أن تكون «خزّافاً»، فهذا يعني أنك في مأزق! ببساطة لأنك تشتغل على خامة صعبة مراوغة تتطلب الكثير من الصبر والقوة البدنية حيث تقضي أسابيع وربما شهوراً تسعى لترويض الصلصال في أفران تصل درجة حرارتها إلى 1450 درجة مئوية عبر عمليات طويلة ومعقدة من الحرق والتلوين، وأي خطأ بسيط في مقادير المواد الكيميائية المضافة يؤدي فوراً إلى تحطم العمل أو على الأقل تشققه. أضف إلى ذلك أنك تحمل فوق ظهرك ميراثاً عتيقاً يمتد آلاف السنين من الإبداعات الخزفية التي قدمتها حضارات العالم على ضفاف الأنهار من مصر إلى الصين ومن العراق إلى الهند، ما يفرض عليك الإجابة عن السؤال الذي يؤرق كل صاحب قريحة مبدعة: كيف وسط هذا الإرث الإنساني الهائل أعثرُ على بصمتي الخاصة وأقدم ما يمكن اعتباره إضافة ما؟ مصرياً، يمكنك وأنت مطمئن البال أن تضيف إلى التحديات السالفة مأزقَ التجاهل الإعلامي لفعاليات فن الخزف واستعلاء النقاد على تجلياته المختلفة وعدم حماس أصحاب القاعات لاستضافة معارضه، وكأن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الأطراف كافة على أننا إزاء إبداع من الدرجة الثانية إذا قورن بالرسم والنحت ضمن أولويات الحركة التشكيلية المعاصرة!
في سمبوزيوم القاهرة الدولي الرابع لفن الخزف الذي استضافته قاعة «الهناجر» أخيراً، تتراجع قتامة هذه الصورة لتتقدم القريحة المشتعلة التي لا تركن إلى الثابت ولا تستظل بالمألوف والعادي، بل تسعى إلى خوض مغامرتها الجمالية حتى النهاية وارتياد آفاق غير مسبوقة. واللافت أن هذا يحدث بأنامل متحمسة لفنانات تتراوح أعمارهن ما بين الجيلين الجديد والوسط، فمن بين تسعة عشر فناناً مشاركاً كان للجنس الناعم نصيب الأسد عبر ستة عشر فنانة.
لا يحتاج الزائر سوى نظرة بانورامية متأنية حتى يدرك أن الأعمال المشاركة يتقاسمها الكثير من الثنائيات: المعاصرة في مواجهة التراث لا سيما الشعبي منه، الذكورة في مواجهة الأنوثة، هدوء الأبيض والأسود في مواجهة صخب الألوان. إنها ثنائيات ممتدة على مستوى الشكل والمضمون، تكسب المنحوتات المصاغة من خامة البورسلين تنوعاً وحيوية وتؤكد تجاوز فن الخزف لوظيفته البدائية كآنية للطعام وتحوله إلى إبداع قائم بذاته. مروة زكريا؛ هي صاحبة الطلقة الأولى في معركة ترويض الخامة ووضعها في حالة من التجريب. تشكيلات شبه مستديرة ذات تعرجات لونية على خلفية بيضاء معلّقة على الجدران تتدلى منها وجوه أطفال. إنها وجوه لا تعرف البراءة المتوقعة بل تبدو مقبضة، وكأنها تكتم سراً ما. هناك ما يؤرقها ولا نعرفه، مثل أشباح عادت من العالم الآخر وهي لا تحمل أخباراً جيدة! هنا تبدو مروة قريبة للغاية من الطابع المميز «للسيرياليين الجدد»، لكن ما أسهل أن تكون «سيريالياً» وأنت تمسك بالفرشاة وترسم على مسطح أبيض من القماش ما عنّ لك مِن أفكار لا يحكمها المنطق المعتاد، وما أصعبه وأنت تنحتُ صلصالاً في درجة حرارة جهنمية!
وبعيداً مِن هذه الأجواء الموحية بالرعب، تعيدنا ولاء بشير إلى تلك اللحظة الحميمة التي تتوهج بالحنين في ذاكرة المصريين، وأعني بها «أبراج الحمام» فوق أسطح الفلاحين قديماً حين كان الريف المصري لا يزال يحتفظ ببراءته ونقائه قبل غزو الأطباق الهوائية والأبنية القبيحة وتراجع المساحات الخضراء تحت زحف جحافل الإسمنت. لا تكتفي ولاء باستلهام الشكل البيضاوي للأبراج ذات العيون المربعة عبر سطح أملس ملوّن يتجنب الزوايا الهندسية الحادة، وإنما تنحت الحمامة نفسها ككائن وديع أبيض يرقد في سكينة على البيض بجوار كل برج. رشا سليمان التي سبق وأبدعت كرسامة في تقديم تيمة الأشجار والجسد الأنثوي عبر تجلياته المختلفة، تقدم هنا تجربتها الأولى في التعامل مع البورسلين. حالة خاصة من نقاء السطح ونعومته لآنية عمودية تتخذ من «البومة» – ذلك الكائن المحير في دلالته ورمزيته والذي يشكل حالة خاصة من العشق لدى الفنانة – شكلاً فنياً استطاع خطف الدهشة مِن عيون كثير من رواد المعرض. وبينما اختارت ميرفت السويفي تقنية «البريق المعدني» عبر معالجة خاصة تجعل البورسلين يبدو كما لو كان معدناً يلمع بألوان متفاوتة وإن كان يغلب عليها لون طمي النيل أيام الفيضان قبل إنشاء السد العالي. لم تبال منال أيوب بالتجديد في الشكل المنحوت وراهنَت على الغرق في شلال من اللون الأزرق بدرجاته المختلفة. أما هبة عريبة وهدى محمد، فلجأتا إلى استلهام ملامح الفن الشعبي لاسيما السلال المصنوعة من الخوص لحمل الفاكهة، فضلاً عن خيوط التريكو والمقص وأدوات الخياطة التقليدية؛ ما منحَ أعمالهما قدراً من الفرادة والخصوصية.
وحتى لا نُتهم بتجاهل المشاركة الرجالي، تجدر الإشارة إلى تجربة الفنان أحمد عبد الكريم في استعادة أحد أقدم أشكال فن الخزف وهو الطبق لكنه يبدو كوعاء من نوع خاص. ليس فقط لتشكيلاته اللونية المتداخلة بل أيضاً لأنه يحمل صورتي الرجل والمرأة في مواجهة بعضهما البعض واللتين تشكلان معاً ما يشبه أسطورة بدء الوجود، آدم وحواء في طبعتهما الأولى، أنوثة وذكورة تسترجع براءة مضت وفطرة أفسدها عصر الهواتف الذكية.