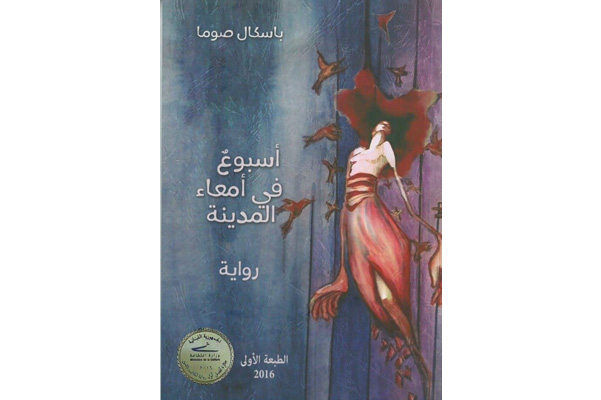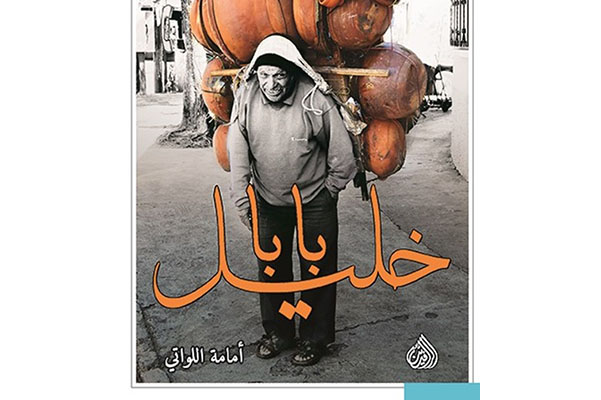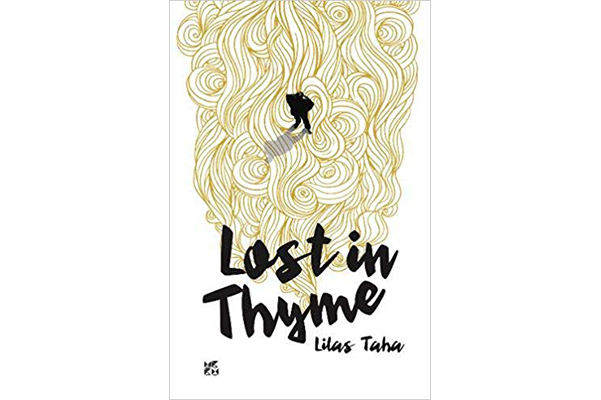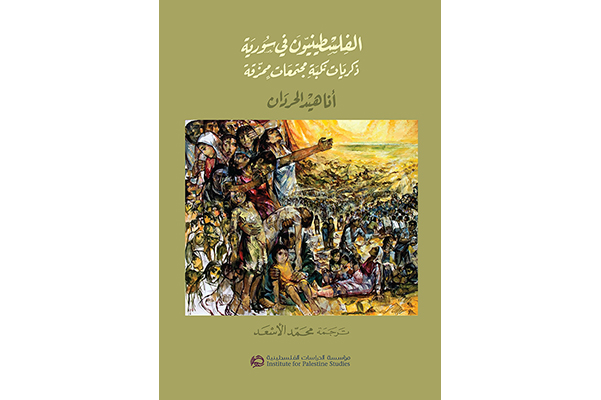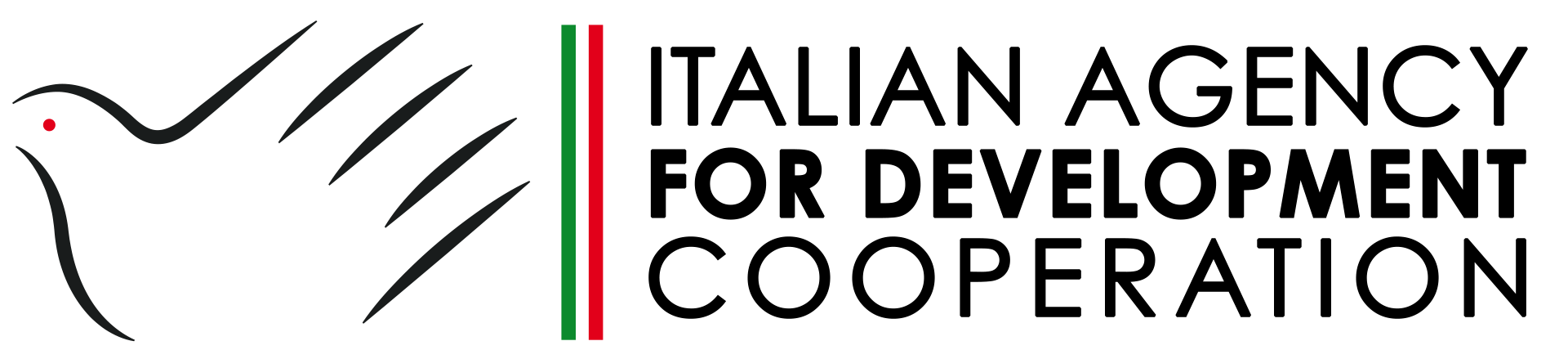"مجة جنى" تؤكد بسكال صوما، لمن ينشد الحياة سخرية، في فراغات المدن الممتلئة بؤسًا، أنّ خفافيش الليل ينهشون الفرح والحزن الجميل، مستأنسة برقص الظلام على قبور "موتى تدفن موتاها"، خلال قصّة "أسبوع في أمعاء المدينة" التي حازت على جائزة وزارة الثقافة كأفضل وأول رواية لكاتب ناشئ عام 2016.
كانت الكلمة للحرمان الخارج من السطور، فقد ظهرت اللّعنات في العمل الجماعي خلال الرواية، وكان إيقاع الفقر والجهل، هو منظّم الأفعال القائمة بمقتضى الروتين الأسبوعي، خلال المدّ والجزر بين الريف والمدينة. مهمة هذه الكلمة رقيّ يحرك في الإنسان الرغبة في ما يمكن ويجب تحقيقه. عالم التخيّل الذي فتح للكاتبة أبوابه، ليس سوى العالم الواقعي، فكانت #كتاباتها على درجة مرتفعة من التطور الفلسفي والاجتماعي. ويمكن القول أن القصّة هي لغّة الشعب المحبط، التي استلهمها من الواقع التراجيدي ونزاعه. فكانت هذه القصّة معاصرة للأمل، الذي يقطن مخيلة أبناء الريف، ويعبر بهم إلى المدينة ليجد كل شيء تحوّل إلى ضده. لم تصف الكاتبة قلب المدينة النابض، ولا فكرها الراقي، فقد غابت مهمة الصروح الثقافية والعلمية عن السطور. لكنّها ظفرت بأكثر ما يمكن من الشغف بالقراءة، فهي رغبت في أن ينصهر بعضها بالبعض الآخر، لكنّ بعضها وخز البعض الآخر بأشواكه بفظاظة. وكل ما كتبته عن أمعاء المدينة عواطف متناقضة وعدائية. لكن الحبّ والفن سكنا هذه العواطف بشكل مجنون لا تفسير له في نزاعات مشاعر الشعوب. وجدت السمك مقتولًا، والضوء تائهًا ومشتتًا مع أثواب السباحة، التي عشقت الأشعة اللّاهبة، وكان عمر بطلة القصّة "سردابًا من النهايات". كأنك تقرأ الشاعر إيليا أبو شديد: "هالدني ورشة/ وترابها كمشة/ في تراب باقي تراب/ وفي تراب عن يمشي"، عندما تمّر أمامك عبارات فاقدة الجدوى بأمل ولو ضئيلًا: "تجلس على الشرفة لتراقب الخيبات تتمشى ذهابًا وإيابًا". متاهات تسكن الأمكنة والأزمنة والأشخاص، مصائر تُربط بأحذية دون وجهة محدّدة، موتٌ ترِفٌ دون طقوس، فقدان القسوة عند الرحيل، لكن رغم كل هذه الغوغاء، يبقى للحبّ فعله وسحره: "كان البعض يعود إلى الحياة عندما يشعرون ببعض الحبّ". وتبقى القبور في أمعاء المدينة "مكانًا مفعمًا بالبساطة والحقيقة"، هذه الحقيقة التي أعتقت ساكني الأمعاء من واقع الحياة، فأصبحوا يشهدون لها وهم أموات .
من يكتب يبق في قيد الحياة والكآبة طوال الوقت، (فنيكولاس) الذي "كان يكتب بشراسة" بقي في نظر الجميع كاتبًا فاشلًا، ليس لأن كلامه غير جميل أو فارغ من المعنى، بل لأنّ أحدًا لم يقرأ ما كتبه، فينطبق عليه ما جاء في الكتاب المقدّس العهد القديم في سفر الجامعة: "ففي كثرة الحكمة كثرة الغم، ومن ازداد معرفة ازداد كآبة _جا 1/18". أشباه البشر في ساحة الخميس، وقبل الانعتاق الموقت من قسوة الأمعاء إلى الريف في نهاية الأسبوع، يتهافتون ويتقاتلون للفوز بالخيبات. ينسبونها لأنفسهم بفخر وجهر أمام سلطة حضر جسدها وغاب عدلها. تلك الخيبات المتناسلة والمتعددة، جعلتهم بعيدين من المطالبة بحقوق يتمتّع بها الحيوان دونهم: "نسوا الثورة في أفواههم، علّقوها، ثم شنقوها وماتوا". كيف يمكن أن يتساوى الخبز والموت؟ "ولا أحد هنا يستطيع تحمّل الضوء كل يوم"، هل لأن الضوء يسكن قبورهم؟. لهذا فصلت الكاتبة بين الروح والجسد، جاعلة الروح في تناقض مع واقع الشهوة الجسدية، لتبقى على قيمها حتى ولو غادرت هيكلها: "الموت نعمة... هؤلاء الموتى، يستطيعون العودة إلى منازلهم ولا يشعر بخطواتهم أحد".
من أهم خيبات أمعاء المدينة الخيانة، فهي تسيطر على الأرواح التي تعشق العطور الجاذبة للخطيئة، وتركض وراء أجودها: "كما فاحت رائحة عطر فرنسي جميل، يعود لامرأة خانها زوجها مع عطر آخر".الجميع لا يعرف اسمها، وحده نيكولاس يحبّها دون اسم ودون أمل: "لكنّ نيكولاس كان يراها بقلبه، يشعر بالجهة التي تهبّ منها انفاسها". تلك البطلة الفنّانة التي مارست الهموم حذرًا، كي لا تقع في "فجوة بينها وبين الحياة"، كانت نانا الطفلة اللطيمة الهاربة من غابة الأسماء الوهمية إلى غربة المدينة، نانا اللّعبة التي لا تشيب ولا تشيخ، التي تعلّقت بابتسامة الكهنة المتّسعة، وحفظت مرارة الوجوه السعيدة في ريفها الجميل، نانا الفنّانة التي اندمجت في فنّها حتى الفناء، فكانت هي ولوحتها روحًا واحدة، نانا التي عانقت فنّ الماغوط كأنها تعانق حزن العالم، هي التي أرادت "أن تكتشف هذا الصنف من الناس المدججين بالورق والأقلام"، لأن القلم أخطر من البندقية في حربه ضد فساد الأسياد، هي البطلة التي عشقت الأدباء المدافعين عن البروليتاريا المعذّبة، هذه البطلة قد ماتت روحًا وجسدًا نهاية القصّة، لأنها كانت تمثل حضارتين لا تندمجان: حضارة الشغف بالأرض والحقول في الريف، وكرم أهله، وأخرى تسير في نهج ثقافة البؤس والتفجير والحرب والتهجير والكراهية في أمعاء المدينة. قالت لنا باسكال صوما: "إنّ مخزون التعاسة فضّ القانون"، وإنّ المحبة في عروق ساكني المدن تحولـت إلى جفاء يصيبهم بجلطات اجتماعية. وإنه لا مجال لفسحة خضراء في صحراء الجهل والحرمان والجهالة: "إنّ الناس في الخارج يتظاهرون، مطالبين بحديقة... وقد منع الكلام نهائيًا". عند قراءة بسكال صوما نثور بوجه من يرمقنا بنظرته المعهودة من الإزدراء، والذي ورثنا من ممارسة مسؤولياته، العبث بالأفكار البالية والسخرية الدائمة من الحياة الفاضلة. تواطأ شذى الحبر الجميل مع طيف الأشخاص العذب المعذّب، لكنّ الحلم لم ينبلج، بل ترقرق صحوه الحزين مع سكون ليل لا صباح له، حين عزفت بسكال صوما الغروب أنشودة موت في "أمعاء المدينة".
المصدر: النهار