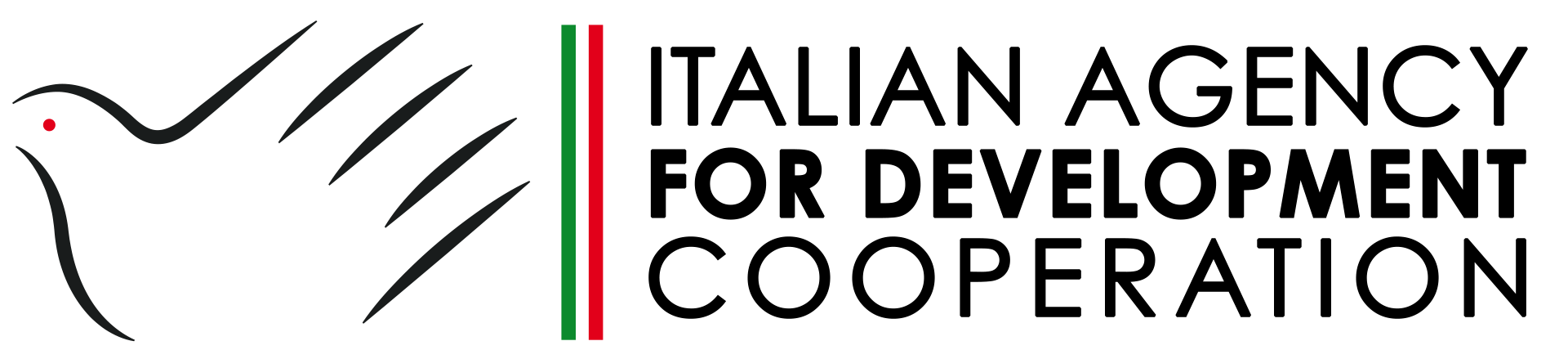"مجلة جنى" القصص التي تؤلمك ليست تلك التي يؤلفها أصحابها، بل تلك التي عاشوها من أجل الأدب ولم يتسن لهم أن يكتبوها، قصص شبيهة في ألمها بما يكفي لتشعرك وكأنك مسؤول عما حدث لأبطالها.
مثل قصة جون كينيدي تول، الذي انتحر في الثانية والثلاثين من عمره، بعد أن أصيب باكتئاب عميق جراء رفض نشر روايته، والألم لا يكمن هنا، بل في تحالف الجميع ضد نصه، ورفضه، كان ذلك كافيا ليحطمه هو الذي كان مقتنعا بعبقريته وفرادة ما كتب.. مات تول وتمكنت والدته من إيجاد ناشر لروايته «تحالف الأغبياء» وباعت الرواية فوق المليون ونصف مليون نسخة، محققة نجاحا لا مثيل له، كما توجت بجائزة بوليتزر صاحبها الراقد في قبره.
الشيء نفسه حدث في تونس، في مطلع هذا العام حين انتحر الكاتب التونسي نضال الغريبي لأسباب مماثلة، وإن كانت أثقل بكثير، فالكاتب الشاب أنهكته الحياة العربية من كل النواحي، ولعله عاش فترة لابأس بها كمن يقضي مدة المؤبد في سجن عجيب، إذ من سوء حظه أن التغيرات التي هبت على تونس ومنها على العالم العربي كله كانت سامة، وقد سممت كل مظاهر الحياة. بالنسبة لكاتب شاب، في مقتبل العمر، لم يكن الأمر سهلا لينهي حياته، إلا في حالة واحدة هي بلوغ ذروة اليأس بدون رؤية أي بارقة أمل في الأفق.
لقد هجمت التغيرات السلبية على العالم العربي منذ هزيمة 67، وربما سبقت هذا التاريخ بقليل، حين هبت البدائل الأيديولوجية الغريبة علينا، ونخرت أدمغتنا حتى بتنا شعوبا تدمر ذاتها بشتى الوسائل، وما نعيشه اليوم استمرار لهذا التدمير الذاتي لا غير.
انتحار الغريبي في الميزان الإعلامي لا شيء أمام انتحار البوعزيزي مثلا، فالرجلان يختلفان كثيرا، على الأقل من باب استغلال موتهما إعلاميا، فالبوعزيزي بائع خضرة يمثل الطبقات المسحوقة من شعوبنا، وحادثة انتحاره حرقا ارتبطت بحادثة أخرى، حين صفعته شرطية، كان ذلك سببا كافيا لجعل الفئات الشعبية المشبعة بالكراهية تجاه المرأة، تثور ضد تلك المرأة التي ترتدي بدلة رسمية، والتي كانت تمثل بشكل ما «النظام» بكل عيوبه، حسب منظور الشعوب العربية غير الراضية على خروج المرأة للعمل، فما بالك أن تشغل وظيفة في المؤسسة الأمنية. أما الثاني فهو كاتب ومثقف، ونضاله فكري، وأهدافه سلمية، حتى في معارضته للأنظمة السائدة جمعاء، فإن وسيلته للتغيير تبدأ من إنارة العقول، لا بالعنف والفوضى، وتسليم السلطة لمن هم أسوأ ممن سبقوهم.
شنق الغريبي نفسه، وانتهت حياته، كما انتهت حياة خليل حاوي، وكوكبة الشعراء والكتاب المنتحرين، مثله مثل غيره من المكتئبين بسبب أوضاعهم الخاصة.
انتهوا جميعهم إذن، وتوقف ذكرهم سوى في مناسبات جد نادرة، غالبا ما تكون حادثة انتحار جديدة، تفتح الجرح المندمل في الحقيقة، كوننا متعودين بشكل ما على عدم التعاطف مع المنتحر، وكوننا أكثر من ذلك، لا نتعاطف حتى مع الأحياء.
أقساة نحن إلى هذا الحد؟
يبدو الجواب واضحا حين نقرأ رسائل أولئك المنتحرين، وكلماتهم الأخيرة لذويهم قبل أن ينهوا حياتهم، لقد عانوا من التخلي، من الأشخاص الأكثر قربا لقلوبهم، ماتوا حزنا قبل أن تتوقف عن النبض بإرادتهم، ماتوا كمدا بعد أن نضبت كل محاولات الإقناع التي قاموا بها، لكنهم أيضا ماتوا من الجهل الذي غمرهم من كل الجهات، لقد وُجدوا في المكان الخطأ مع الناس الخطأ، حتى إن ذهبت التفسيرات العلمية إلى أسباب أخرى، أكثر تعقيدا من أسبابنا الأخلاقية والاجتماعية، إلا أن الأمر يبدو دائما غريبا بالنسبة إلينا حين نتحدث عن انتحار الكتاب في ثقافة مغايرة لثقافتنا، مثل انتحار الكاتب الجنوب إفريقي كارل شويمان الذي تعب من المرض، وأراد موتا رحيما رفضته قوانين بلاده، إذ يبدو أن الأوجاع الجسدية المرافقة للشيخوخة هي ما أزعجته، أو لنقل تجاوزت قدرات احتماله، وهنا تكمن فروق أخرى بين مفهومين للانتحار، فهناك انتحار نابع من الوعي وآخر نابع من فقدان ذلك الوعي، وما يليه من فقدان للسيطرة على الذات.
هناك انتحار تليه حياة أخرى للكاتب، بحيث يعاد إنتاجه بصيغ مختلفة، وهناك انتحار مستمر، يعاد إنتاجه كنموذج لصيق بالهزيمة، انتحار لا يعني سوى الموت المتكرر، الموت الذي نتعوده لدرجة أنه لا يهزنا، ولا يغير فينا شيئا، موت ألفناه وألفنا هو الآخر، فهو يعيش بيننا متنكرا أحيانا وأحيانا أخرى واضحا عاريا، مقيتا، مقرفا، ومع هذا نفضله عن الحياة التي ترعبنا بكل طقوسها، من حب وجنس، وبناء، وعمران، واجتهاد، ونضال متواصل من أجل البقاء…
يختلف انتحار تول عن انتحار الغريبي مع أن نقاط تلاقيهما مرعبة، فكلاهما كاتب، وكلاهما أنهى حياته في الثانية والثلاثين من عمره، بسبب الرفض الذي عانى منه، ولعل الغريبي أيضا تنطبق عليه مقولة تول: «تعرف العبقري لحظة ظهوره في العالم بهذه العلامة: الأغبياء جميعا يتحالفون ضده»، لكن من دق باب بيته بعد نهاية مراسيم العزاء؟ من طرح الأسئلة التي يجب طرحها عن حياته؟ من عاد إلى ذويه ليعرفه أكثر؟ من الواضح أن الفروق تزداد اتساعا كلما اقتربنا من كليهما، فالأول مات ولكن عبقريته خُلدت، والثاني مات ودفنت معه عبقريته!
الأول مات في أرض الأحلام، حيث ينبعث الراحل مثل طائر الفينيق من تحت الرماد، والثاني مات في مقبرة الأحياء، حيث الأحلام لا تتراءى إلا للنائمين، وكلما ظل الفرد فيها نائما، طالت أحلامه. تختلف مفاهيم الموت عندنا، كما تختلف طقوسها، وطقوس استحضارها، ولعلي كثيرا ما أشرت إلى الاحتفاليات البائسة التي يقوم بها البعض لإحياء ذكرى وفاة كاتب ما، مع أن الأجمل هو إحياء ذكرى مولده، كنوع من الاستمرارية لأدبه وإبداعه، فلطالما أحالتنا طقوس تذكر الموت لإعادة سيناريو العزاء، بكل محمولات الحزن التي يتأنق بها، ولطالما وضعتنا تلك الاحتفــــالات التأبينــــية في مواجهة نهاياتنا، وتعداد الخسارات التي ابتلينا بها على مدى عقود من الزمن.
تنتهي حياة كُتابنا ومبدعينا بعبثية غريبة، لكن أسوأها على الإطلاق هي تلك النهايات التي نقررها نحن بتواطؤ لا تفسير له مع كل شياطين الشر في هذه الأكوان، فنحاصر الكاتب بعتاد لا يمكن مجابهته، يبدأ بتجويعه، ويستمر بإذلاله، وتحقيره، وإرهابه، وإرعابه، وينتهي بدفنه حيا في مربع يشبه أبشع السجون في العالم، حيث يتحول فيه الجميع إلى مراقبين وجواسيس ترصد أدنى حركاته، فلا العائلة عائلته، ولا الجيران جيرانه، والوطن وطنه، كل ما حوله مجند لمحاكمته، وإطلاق الأحكام القاسية ضده، ولن أكتب هنا أقسى وصف سمعته بشأن الغريبي، لأنه لا ينطبق عليه، لكنني أذكركم أن عبقرية الرجل لا تزال بين أشيائه، ومن غير المنصف أن تدفن معه.
بقلم بروين حبيب: شاعرة وإعلامية من البحرين
المصدر: قاب قوسين