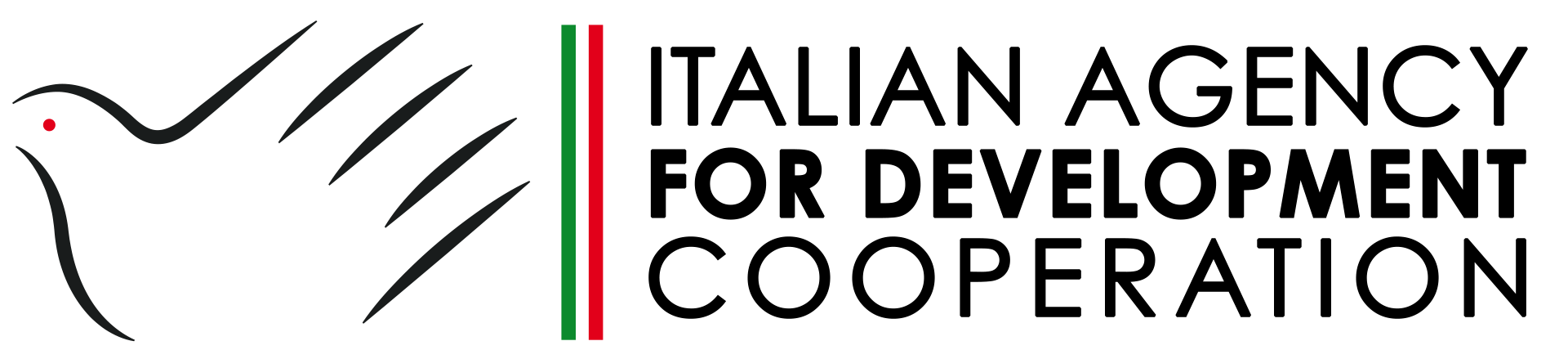شادية عمر كمال في "جرائم لا يعاقب عليها القانون"
فراس حج محمد/ فلسطين

"مجلة جنى" يثير كتاب "جرائم لا يعاقب عليها القانون" لصاحبته شادية عمر كمال، العديد من الأسئلة ويطرح الكثير من المسائل، كتاب يوظف هذا الكم من حيوات الناس وأقدارهم لصناعة القصة، كتاب جدير بالوقوف عنده وتأمل مادته السردية، سواء على صعيد الشكل أو على صعيد المضمون. فقد جاء الكتاب في "400" صفحة من القطع الكبير، ابتدأته بإهداء ومقدمة قصيرة، ثم أخذت تسرد قصصها العشر، وقد جاءت الثماني الأولى من القصص ذات مناخ قصصي واحد، وعلاقات واحدة بين الشخصيات، لتكون القصتان الأخيرتان مختلفتين، ليس في الموضوع، وإنما في الشخصيات، فشخصيات هاتين القصتين لا تربطها علاقات بين الشخصيات التي شكلت القصص الأخرى إلا رباط السارد نفسه، كما سأوضح لاحقا.
الكتاب والشبهة الروائية:
لقد جاءت هذه القصص كلاسيكية في سرديتها وموضوعها، ولم تلتزم الكاتبة بمنطق القصة القصيرة، وخاصة فيما يتصل بعنصر الزمن، وحجم القصة، إذ إن هذين العنصرين من أهم العناصر التي تجعل السرد قصة قصيرة، فقد كان الزمن في هذه القصص ممتدا إلى سنوات متعددة، وطال السرد لتشكل كل قصة ما يشبه "النوفيلا" أو الرواية القصيرة، مع أن الكاتبة في مقدمتها تنص على أنها تريد أن تكتب قصصا قصيرة، وليست روايات قصيرة.
تشترك هذه القصص فيما بينها برابطين اثنين يؤهلها لأن تكون رواية، فالشخصيات المتحركة في فضاء السرد هي نفسها في القصص الثماني الأولى، وإن كانت تركز الكاتبة في كل قصة على محور حياة شخصية من هؤلاء النساء العشرة، وهذا البناء الفني وإن لم تكن الكاتبة تعيه بشكل واضح، إلا أنه شكل الإطار العام لهذه القصص، وقد أشار الناقد الدكتور محمد عبد الله القواسمة إلى تقنية كتابة الرواية بتوظيف القصة القصيرة من خلال مناقشته لبعض الأعمال القصصية في مقال حمل عنوان "رواية القصة القصيرة"، ونُشر في صحيفة الدستور الأردنية.
وقد قيل عن بعض الأعمال القصصية ما ينطبق على قصص هذا الكتاب، كالمجموعة القصصية "سداسية الأيام الستة" لإيميل حبيبي؛ إذ اعتبرها بعض النقاد رواية، وليست مجرد مجموعة قصصية متناثرة القصص. والشيء نفسه يقال عن المجموعة القصصية للكاتبة الجزائرية أمل بوشارب "عليها ثلاثة عشر"، فهذه المجموعة كما صرحت الكاتبة في حوار معها "عمل يتضمن ثلاث عشرة قصة قصيرة تكاد ترتبط عضوياً ببعضها البعض إذا ما تمت قراءتها بنفَس واحد، على نحو تتابعي متصل لتجد حلاً لعقدتها جميعاً في القصة رقم 13، لكنها من ناحية أخرى يمكن أن تقرأ كقصص منفردة دون أي ترتيب كأي قصص قصيرة أخرى تتمتع بحقوق وواجبات هذا الجنس الأدبي". ولا تبتعد مجموعة طارق إمام "مدينة الحوائط اللانهاءية" عن هذا البناء الذي يتراوح بين القصة القصيرة والرواية، إذ يمكن قراءتها "كقصص، وبنفس القوة تطرح عالمًا متصلًا يجعلها قابلةً للقراءة كرواية".
وأما من الأدب العالمي فسأشير إلى ما يشبه عمل الكاتبة فيما أصدره الكاتب والفيلسوف الفرنسي جورج باتاي من مجموعته القصصية "حكاية العين"، فهي مجموعة قصص، ولكن الشخصيات هي عينها التي تتحرك في الفضاء السردي، ومن زاوية أخرى، ولاتصال هذا الكتاب بالشبهة الروائية أشير إلى رواية "عشر نساء" للكاتبة التشيلية مارثيلا سيرانو، إذ تتحدث هذه الرواية عن حيوات متعددة لمجموعة نساء، ومع أنه يمكن أن تقرأ هذه القصص بوصفها قصصا مستقلة إلا أنها تشكل معا لوحة روائية ذات هدف محدد، وهذا ما كان في كتاب "جرائم لا يعاقب عليها القانون"، حتى لو أشرك الدارس القصتين الأخيرتين في هذا النسيج الروائي القصصي، على اعتبار اشتراكهما في الموضوع.
وعدا هذه الأعمال المشار إليها سابقا، فإن هذا الكتاب، فيما يخص موضوعه واتصاله بحياة النساء، فإنه تقفز إلى الذاكرة أعمال أخرى مشابهة، وخاصة رواية "نساء" لتشارلز بوكوفسكي، ورواية "الجنس والمدينة" للكاتبة الأمريكية كانديس بوشنيل، وفي هذه الرواية بالتحديد، ثمة عوالم متشابهة وخاصة فيما يتعلق بالنساء موضوع القصص عندشادية كمال وعند بوشنيل، فالنساء عاملات عزباوات، يبحثن عن الاستقرار، والنجاح في العمل، ولكن أيضا يرتبطن بعلاقات حب وما يتبع ذلك من تصرفات وممارسة الحب، وأما رواية بوكوفسكي فإن هذا الكتاب يشترك معها في تلك الجرائم التي "لا يعاقب عليها القانون" عندنا، وتلك الممارسات التي يجدها القارئ في رواية بوكوفسكي، وفي تلك النهاية التي تحددت في مسار حياة الشخصية الرئيسية، هنري شناسكي، وابتعاده عن كل النساء ليرتبط بامرأة واحدة.
القصص وعلاقتها بالواقع:
يبدو من المناسب التذكير بما جاء في خاتمة رواية "عشر نساء" مارثيلا سيرانو، عندما تحدثت إحدى النساء قائلة: "جميعنا في نهاية المطاف، بطريقة أو بأخرى، لدينا القصة نفسها، التي يمكن أن نرويها". فهذا الاشتراك لهذه الجرائم مع الأعمال السالفة الذكر، لا يقلل من أهمية الكتاب ومادته الزاخرة، وعوالمه الخاصة، ومع اشتراك بعض الناس في بعض التفاصيل في الحياة إلا أنه لا بد من أن يكون هناك الخصوصية لكل كاتب فيما يكتبه، وفيما يوظفه من خبرة شخصية. وعلى الرغم من أنه لا رواية من كلاسيكيات الرواية العربية تخلو من موضوع هذا الكتاب، لاسيما روايات إحسان عبد القدوس وبعض روايات نجيب محفوظ، وما شاع من أعمال درامية في الستينيات والسبعينيات، إلا أن للكتاب ميزة خاصة على مستوى الموضوع، إذ يرصد الكتاب تجارب ثمان من النساء عملن مضيفات طيران، ما يعني أنه يعطي للقارئ فرصة التعرف على هذا العالم، هذا العالم الذي تصفه الكاتبة بقولها: "جو الطيران وعالمه يعطي للعواطف والعلاقات إحساسا مميزا طريقه معبد، ودنياه فيها الكثير من الإثارة والغموض". (ص25)، ولذلك فإن هذا العالم شكل مناخا طبيعيا لولادة تلك القصص الرومانسية، على اعتبار أن "الحب هو المرض المتفشي في عالم الطيران". (ص28). عدا أن الكتاب يصلح أن يكون وثيقة اجتماعية على الفترة التي تشكلت فيها الحكايات، وتمتد لأكثر من ثلاثين عاما، مع أن القارئ لم يلاحظ التغير في بنية المجتمع الفكرية بين أول قصة وآخر قصة، ولعل هذا مؤشر سلبي على جمود المجتمع وعدم استجابته للتغيرات التي يجب أن تنقله من حال إلى حال. وفي ظني أن هذا ليس قصورا من الكاتبة التي التزمت طريقة السرد المحايد والتسجيلي والواقعي، فهذا الالتزام حقق بالضرورة صدقا واقعيا على ما تدل عليه الأحداث عند دراستها وتفكيك بنيتها الثقافية والفكرية. وعلى ذلك يمكن أن يعد الدارس هذا الكتاب مجموعة من القصص التسجيلية التي حدثت في الثلث الأخير من القرن العشرين كما جاء في المقدمة، وإن نفت الكاتبة أن يكون لهذه القصص "أي وجود حقيقي، في يوم من الأيام" (ص7).
سأتوقف قليلا عند ملاحظة الكاتبة هذه في مقدمتها، ونفيها أن يكون لهذه القصص أي صلة بالواقع، وهذا الاحتراس المعهود من كتاب الروايات، وكنت قد أشرت إليه في دراسة مطولة منشورة في كتابي "ملامح من السرد المعاصر- قراءات في متنوع السرد".
إن هذا الاحتراس كما بينت الدراسة هو لفت انتباه للقارئ ليفكر على عكس ما يريد الكاتب ظاهريا؛ إذ لولا تلك الشبهة الواقعية لما دار في خلد الكاتب أن يسجل مثل هذه الملاحظة. على أن الوقوف عند هذه الملاحظة يجب ألا يحول الناقد إلى مفتش مباحث أو محقق سري، وإنما لا بد له من أن يبين أمورا تتصل بالفن القصصي عموما الذي أضحى مرتبطا بشخص الكاتب وتجاربه الشخصية، ولا بد من حضور تجاربه فيما يكتب، هذا ما يقرره الكتاب جميعا، وهذا ما يلمسه القارئ في أعمالهم. تأخذني الملاحظة السابقة إلى البحث عن موقع السارد في القصص العشر، وهل يمكن اعتبار السارد هو الكاتبة نفسها؟
موقع الكاتبة في السرد:
لن أكون مغامرا في هذا الربط إلا لأن هذه القصص هي قصص حقيقية وليست واقعية فقط، وعلى الرغم من أن الكاتبة لم تظهر شخصية السارد، وظل قابعا وراء اللغة ونقل المشاهد والأحداث، إلا أن ما يلفت النظر وجود شخصية "شادية" في هذه القصص، وأنها كانت واحدة من أولئك النسوة بطلات القصص، ولكنها كما يبدو في أكثر من موقع في القصص أنها اكتفت بالسرد إذ جاء في القصة الرابعة أن "شادية كانت تعمل مضيفة جوية هنا، طويلة وحلوة وزي المانيكان، أنا مش متذكر اسم عيلتها، بس كانت أردنية من أصل فلسطيني". (ص124)، وتتضح مهمة شادية في هذه القصة وكل القصص في أنها لم تكن طرفا في هذا الماضي، "بل كانت شاهدة عليه". (ص125)، إنها وظيفة مقررة من وظائف السارد أن يكون شاهدا على الأحداث. ولم يقف حدود السارد/ شادية عند حدود الشهادة، بل "إن بيدها المفتاح لكل الألغاز" (ص129)، وطبيعي جدا في هذه الحالة أن تكون شادية بوصفها ساردا "بتعرف الكل". (ص131). وعلى الرغم من أن القصص لا تصرح باسم السارد، إلا أنه من منطلق التحليل السابق، فيمكن أن تكون شادية الكاتبة والساردة معا.
إذن، لم تكن شخصية الساردة ثانوية في هذه القصص، وإنما هي المتحكم بكل خيوط اللعبة السردية وتوجيهها الوجهة التي أرادتها لها، وخاصة إذا ما ارتبط هذا التحليل بما جاء في المقدمة: "وحيث إنني في هذا العمر أمتلك زخما من التجارب والقصص الواقعية، قررت أن أحمل قلمي وأكتب". (ص7) إن الكاتبة لا تكتب قصصا خيالية حتى نسلم بملاحظة الروائي ماريو فارغاس يوسا الذي يحذرنا فيها من الاتحاد بين الكاتب والسارد.
لقد بقيت هذه الإحالة إلى العالم الواقعي متحكمة في الكاتبة بشكل كبير جدا، بحيث لم تستطع التخلص من سيطرتها عليها، فقد اضطرتها الحقيقة الواقعية إلى أن تحذف أسماء كثير من الأماكن لتعوض بدلا عن ذلك بوضع فراغات، وتجنبت ذكر البلد التي عملت فيه أو اسم الشركتين اللتين عملت فيهما سواء كمضيقة جوية أو أمينة سر لأحدى الشركات الكبرى المساهمة، واكتفت غالبا بذكر الاسم الأول لشخصياتها. إضافة إلى أنها ذكرت أحداثا كبرى حصلت بالمزامنة مع أحداث قصصها، كحرب أكتوبر 1973، وبدايات الحرب الأهلية في لبنان، 1975، ومقتل الزعيم اللبناني بيير الجميل، وكذلك حرب الخليج الأولى وأحداث عام 1990.
وأما بخصوص أساليب السرد فقد اعتمدت الكاتبة على السارد العليم في رواية الأحداث، وقد تخلل بعض القصص الحوار الخارجي الذي يدور بين الشخصيات، ووظفت في واحدة من القصص أسلوب الرسائل، واعتمدت في القصة الأخيرة على تضمين القصة مذكرات الشخصية الرئيسية، ما يعني من وجهة نظر نقدية محاولة الكاتبة البعد عن الكلاسيكية في سرد الأحداث.
الكتاب ومعصلة الأفكار السائدة:
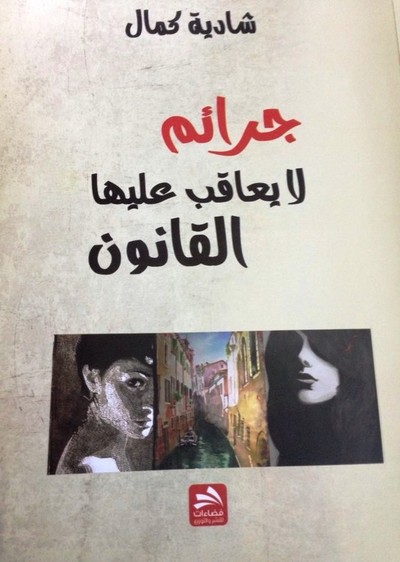
لا شك في أن كتابا كمثل هذا الكتاب ويستند إلى خبرة شخصية ويعالج موضوعا مهما، كما سبق وذكرت، سيطرح في ثنايا تلك القصص مسائل تتصل بالمجتمع وأفكاره السائدة فيه، بدءا من وضع المرأة العربية وصورتها في تلك الفترة، وصورة الرجل، وما تحيل العلاقة بينهما من مسائل أخرى تتصل بالمعاشرة الزوجية، والزواج التقليدي، وحرية المرأة، والنظر إلى موضوع العفة والعذرية، والزواج المختلف دينيا، والعلاقات الشرعية والمحرمة، والزواج السري والزواج العرفي، وافتقاد الحرية في الوطن، وممارستها على أكمل وجه في البلاد الأجنبية.
لقد ظهرت المرأة في القصص العشر، في عمر الشباب الغض، تشبه قطعة "البسكويت"، متعلمة، جميلة، بل فائقة الجمال، لكنها لم تكن امرأة مثقفة، أو مهتمة بالشأن الثقافي، امرأة لا تعرف الكتب، ولا الفعاليات الثقافية حتى السينمائية، امرأة تحب العمل وتريد أن تحقق ذاتها فيه، وترغب في الحب والزواج، هي امرأة خاضعة نوعا ما للأفكار السائدة، وفي الأعم الأغلب، ستكون ضعيفة في المواجهة العلنية، فلا تمتلك الروح الثورية، بل كانت مسالمة، سواء مع الأهل أو مع الزوج أو مع الحبيب، هذه هي المرأة التي كنا نراها في أفلام الستينيات والسبعينيات وحتى أوائل التسعينيات، ونقرأ عنها في الروايات، مع أن هذه الصورة اختلفت كثيرا اليوم في الرواية العربية، فهناك السياسية والكاتبة والمثقفة والقائدة الجماهيرية والمناضلة، وهنا قد يسجل الدارس مأخذا على هذه القصص، فــ "وظيفة العمل الفني ليست "تصوير" الواقع فحسب، بل أيضا خلقه".
ومن الطبيعي إذن والنساء تتحرك في ظل هذه الأجواء أن نجد الصورة العامة، النمطية، التي يحملها الرجال عن المرأة، وتتلخص في أن تكون جميلة، وصغيرة في السن، وقادرة على الإنجاب، وعديمة التجارب مع الرجال، أو كما جاء في إحدى القصص "ما باس تمها غير أمها"، إذ إن تجارب المرأة وعلاقات الحب السابقة تجعلها امرأة غير مؤهلة لتكون "زوجة صالحة"، كما يتصور هؤلاء الرجال، قد تصلح للحب والمتعة أما أن تصلح للزواج فلا، وهذا ما جاء في قصة شاهندة مثلا التي عاشت مع نبيل قصة حب أعطته فيها على مدار سبع سنوات كل ما تعطيه المرأة للرجل، وعندما تركها جعلها تعيش هذه الأزمة الاجتماعية، ولذلك رفضها محمود الذي كان قبل معرفته بذلك يرغب في الزواج منها رغبة شديدة، ولكن شرقيته منعته أن يرتبط بها. فقد كانت الحقيقة صادمة له ولم يستوعبها، وفي هذا صدق واقعي يتماهى وواقع الرجل الشرقي الذي يربط عفة المرأة وصلاحيتها لتكوين أسرة بالمحافظة على العذرية. لذلك جاء الرد على منطق محمود وأتباعه ومن يفكر على طريقته: "أرفض أن تكون عذريتي مجرد طابع دمغة يتختم من الزوج ليلة الزفاف". (ص256)، ومع ذلك فقد وجد من الرجال من شذ عن هذه القاعدة الاجتماعية، وقبل بالارتباط بشاهندة.
وبموازاة هذه الصورة للمرأة وتعامل الرجل مع تلك الصورة تبرز صورة الرجل الذي تتيح له شرقيته، وكونه رجلا أن يفعل ما يشاء، وأن يمارس حريته كما يحلو له، فتكون له تجارب، وعلاقات متعددة، والمجتمع لا يعتبر كل هذه الموبقات الذكورية "جرائم يعاقب عليها القانون"، لذلك لم يعان الرجال مما عانته النساء في مثل هذه المسألة، وإن بدا بعض الرجال مغلوب على أمرهم أيضا في نواح أخرى وفي مجتمعات معينة، فثمة حواجز لا يستطيع أحد تخطيها، وذلك في أمور تعدد الزوجات، والزواج المختلط دينيا، والوقوع تحت طائلة التسلط العائلي للعائلات الحاكمة، فثمة أعراف لا أحد يخرج عنها، ولذلك فمأساة الرجال في قصص هذه الكتاب نابعة من مشاكل مختلفة، وإن التقت عند نقطة واحدة، وما يلاحظ عليه في حيوات أغلب هؤلاء الرجال أن معظم زيجاتهم كانت ضمن نطاق الزواج التقليدي، فقد كانوا إذن متعطشين للحب وأن يعيشوا تلك الحالات المجنونة، فإذا ما التقت هذه الرغبة مع وجود نساء فائقات الجمال، فمن الطبيعي أن نقرأ مثل هذه القصص الملتهبة في مشاهدها وعواطف أبطالها رجالا ونساء.
لقد تشكلت هذه القصص في ظل مناخ لا يتيح للمرأة إقامة علاقات غير شرعية خارج نطاق مؤسسة الزواج، لكنهن استطعن الإفلات من هذه المعضلة الاجتماعية، وإن ظلت هذه المواجهة سرية، وكأنهن ينتقمن من المجتمع على طريقتهن الخاصة، أو أنهن أردن الحصول على حريتهن أيضا على طريقتهن الخاصة وضمن ما هو متاح لهن، بعيدا عن الرقابة الاجتماعية المباشرة وما فيها من صرامة.
وفي ظني يجب الالتفات إلى هذا الإيحاء في الكتاب، فالرقابة والتشديد والمبالغة يجعل الأمور تتجه اتجاها مبطنا وبعيدا عن الأعين، ما يجعل المجتمع مجتمعا منافقا له صورتان، صورة يراها الجميع ومتفقة مع ما يريده المجتمع، وصورة أخرى تتشكل في الخفاء وبعيدة عن نظر المجتمع لكنها صورة أكثر صدقا من تلك الصورة الظاهرية التي سرعان ما تتهاوى كلما أصبح الإنسان قادرا على التخلص منها. مع أن أغلب أفراد المجتمع يحرصون على انتهاك صورة المجتمع الظاهرية، ولكن بالخفاء، فلا أحد يريد أن يظهر عداءه للأفكار السائدة، بل ربما اضطررنا للدفاع عن فكرة ما بشكل علني مع قناعتنا بأنها خاطئة، ولا نريد لها في وعينا أن تنتصر.
اللغة في الكتاب:
جاءت اللغة في الكتاب لغة بسيطة، سردية، لا تجنح نحو الخيال، أو المبالغة أو التصوير، ولا تعتمد على المقولات الفلسفية، واضحة في رسالتها التي تسعى إلى تحقيقها، وهو توثيق تلك الحكايات في إطار السرد القصصي، وقد عبرت اللغة عن المضمون، خاصة أن الكاتبة لم تلتزم بمستوى واحد من اللغة، بل كانت اللغة موافقة في الأعم الأغلب لحالة الشخصيات، فظهرت اللهجات العربية: المصرية والخليجية واللبنانية، بالإضافة إلى اللهجة الفلسطينية والأردنية.
وما يلاحظ على لغة الحوار أحيانا أن الكاتبة تمزج بين لهجة المتحدث واللغة الفصيحة، وخاصة في الحوارات التي تسترسل فيها الشخصية في الحديث. ما يعد مثلبا ينال من واقعية المشهد وتأثيره في القارئ، إذ يجعل القارئ ينتقل لسانه وفكره ووجدانه بين لغتين، مختلفتي الإيقاع، فيؤدي ذلك إلى إخراج القارئ من حالة الاندماج التي كان عليها، ما يؤثر سلبيا في عمليات التلقي والتأثير والتعاطف الإيجابي أو السلبي مع المشهد.
إن هذا الالتزام ببساطة السرد، أبقى القصص مجرد حكايات منقولة على الورق، وتشبه إلى حد كبير الحكايات الشعبية، وقصص النساء اللواتي يتسلين بها أوقات الفراغ، ومن هنا جاءت كثير من القصص مكررة العبارات والألفاظ والمشاهد، وربما خلق هذا أحساسا من الملل في كتاب تجاوزت صفحاته أربعمائة صفحة، بعشر حكايات رومانسية، مع أن الكاتب أحيانا كانت قادرة على التأثير في مشاعر القارئ، متناسيا تلك الهنات.
لعل امتلاك الكاتب تجربة شخصية هو دافع كبير لكتابتها، ولكن يجب أن يكون واعيا إلى أنه يلزمه متطلبات للكتابة الإبداعية، والمعرفة النظرية على الأجناس الأدبية، لقد كان كتاب "جرائم لا يعاقب عليها القانون" محتاجا لمحرر أدبي، يعيد فيه النظر، فيضبط لغته، ويتخلص من تلك الألفاظ المكررة، ويزيل غير الضروري من المشاهد والأحداث، ويطورها لترتبط معا في حلقات متسلسلة دون الشعور بالتكرار لخلق عمل أدبي إبداعي له القدرة على المنافسة في ظل التطور الحاصل في الفن السردي عموما والقصصي على وجه الخصوص.
ومع كل ذلك، فهي هنات قد تكون عادية، ويمكن التغاضي عنها، إذ إن الكتاب هو التجربة الأولى للكاتبة، فلا شك في أن للخبرة الكتابية دورا في أسلوب الكتابة، وأظن أن الكاتبة بما تمتلكه من طاقة سردية قادرة على تطوير أدواتها في أعمالها القادمة. ويبقى السؤال الأخير هل ستكتب الكاتبة قصتها في قادم أعمالها أم ستبقى مجرد "شاهد عصر" على أحداث عاشت بلا أدنى ريب تفاصيلها وكان لها حكايتها الخاصة بها؟