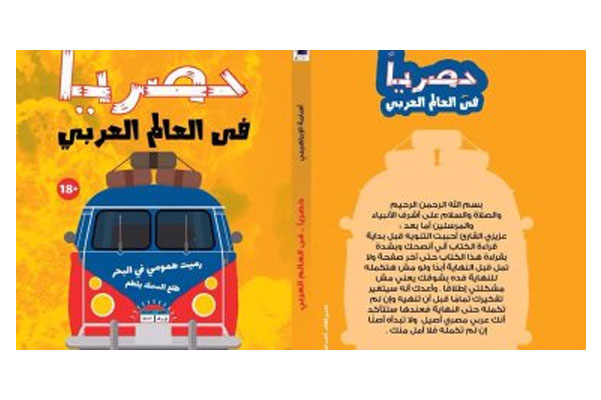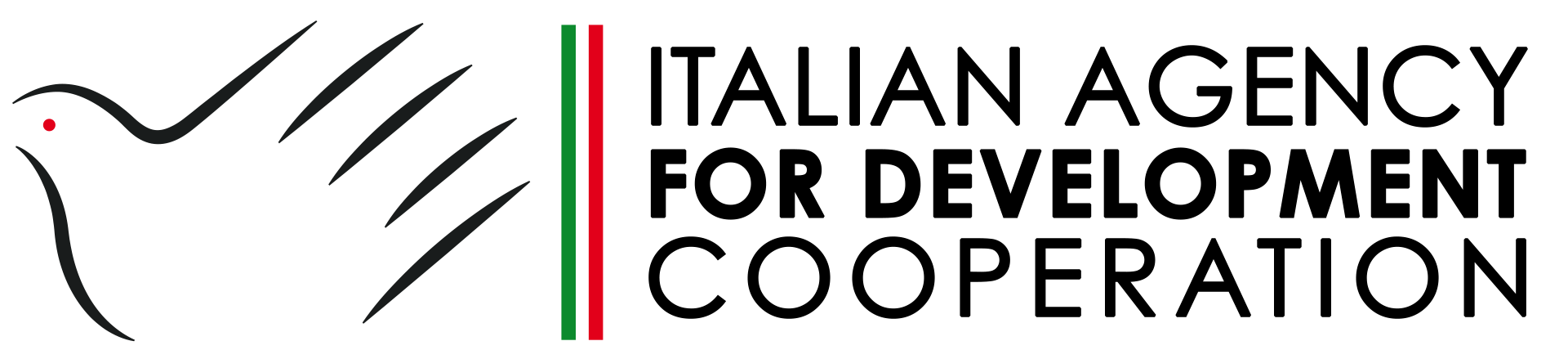أليف شافاك وإيزابيل ألليندي وماريز كوندي في أعمال ثلاثة
"مجلة جنى" لعلهم لا يجافون الحقيقة بشيء أولئك الذين يعتقدون أن الرواية دون سواها هي ملحمة العصر الحقيقية، بعد أن كان لواء هذا الفن منعقداً للشعر في الحقب السابقة من التاريخ. وسواء كان الأمر متعلقاً بحيوات البشر العاديين وتفاصيلها الصغيرة، أو بالتحولات المفصلية للدول والجماعات، فإن لغة السرد هي الأقدر في الحالتين، على رصد هذه التحولات، أو على انتشال ما هو مهمل وعادي ويومي من قاع النسيان. وإذا كانت هذه المقالة تتصدى لأعمال روائية ثلاثة، صدرت مترجمة إلى العربية عن «دار الآداب»، فإن الأمر لا يأتي عن الصدفة المجردة أو المزاج الشخصي، بل لأن هذه الأعمال على تنوعها تتسم بالنفس الملحمي في مقاربتها للوقائع والأحداث، كما أن كلاً منها تعكس الروح القومية لكاتبته، إضافة إلى البعد الإنساني الجامع الذي يحولها إلى صرخة احتجاج مؤثرة ضد القهر والاستبداد والتمييز العرقي والاجتماعي.
في عملها المشوق «أنا تيتوبا: ساحرة سالم السوداء»، تكشف الكاتبة الغوادولوبية ماريز كوندي، عن قدرات روائية عالية، وحبكة أسلوبية متقنة لا تترك للقارئ فرصة لالتقاط الأنفاس، فثمة انصهار تام داخل الزمن الروائي الذي يعود إلى نهايات القرن السابع عشر، تماهٍ تام مع بطلة الرواية التي لا قِبل للقارئ بنسيانها. ورغم أن ثلاثة قرون كاملة تفصل بين زمن الكاتبة وزمن بطلتها، وما استتبع ذلك من حروب وثورات دموية آلت في النهاية إلى إلغاء الرق وإعلان شرعية حقوق الإنسان والمساواة بين البشر، فقد تمكنت المؤلفة من أن تنتشل من قاع النسيان ذلك العالم المر الغارق في وحشيته العنصرية، وفي ملذاته الحسية المختلسة من خلف ظهر الألم. والواقع أننا كقراء لم نكن بحاجة إلى التنويه الذي أوردته كوندي في مستهل الرواية: «تيتوبا وأنا عشنا في صحبة حميمة مدة عام، وأثناء حواراتنا التي لم تكن تنقضي باحت لي بهذه الأمور التي لم تبح بها لأحد»، لكي نعاين لطخات الدم المتيبسة فوق سطوح اللغة، وأنين البشر الذين سيقوا من أحشاء أفريقيا السوداء لكي يباعوا بالمزاد في أسواق النخاسة التي قامت على أنقاضها حضارة أميركا «البيضاء».
عرفت المؤلفة، دون أن تقع فريسة التحريض والوعظ الأخلاقي، أن تقدم شهادتهم الموثقة بالأدلة ضد ذلك العصر القاسي والمفتقر إلى العدالة. وتمكنت ماريز كوندي من أن تقدم لنا من خلال عملها السردي المتوهج كل ما تحتاجه الرواية لتتحول إلى ملحمة حقيقية صنعها البشر المهانون والموصوفون بالعبيد، من تخثر دمهم النازف على قارعة المدن الجديدة، وتشقق لحومهم تحت شمس الظهيرة اللاهبة، وانكسار ظهورهم تحت لفح السياط «البيضاء».
تختزل حكاية تيتوبا «الساحرة» حكاية شعبها المهان بأسره. فالطفلة البائسة التي جاءت إلى العالم من صُلب خطيئتين أصليتين، هما لونها الأسود، وحادثة اغتصاب تاجر الرقيق البريطاني لأمها أبِنا، تنتقل من عهدة مالك مفلس إلى مالك آخر موسر، بعد أن قضت أمها شنقاً بسبب الحادثة، وبعد انتحار الأب الأسود البديل الذي تربت في عهدته. إلا أن الفتاة التي حُملت إلى ضاحية سالم القريبة من بوسطن، بعد أن ضمها تاجر جديد إلى مقتنياته، كانت ككثيرات من السود، قد تعلمت من قريبتها مان يايا العجوز، وقبل رحيلها هي الأخرى، طرق التحدث مع الطبيعة، واستحضار أرواح الموتى، والمعالجة بالتعاويذ والأعشاب، وغيرها من فنون السحر. ومع أن تيتوبا عقدت العزم على ألا تسخر مواهبها إلا في الأعمال الخيرة وشفاء المرضى والتقريب بين الأحياء وأحبائهم من الموتى، فقد وجدت نفسها بالمقابل تواجه تهماً بالسحر والشعوذة قادتها إلى السجن والاضطهاد، بعد أن غدر بها كل من جهدت في مساعدتهم، وتخلى عنها زوجها جون الهندي الذي لم تستطع نسيانه، حتى نهاية حياتها القصيرة. ومع أن تيتوبا وجدت نفسها أمام فرصة نادرة للظفر بحياة طويلة هانئة بعد خروجها من السجن، وبعد أن أعتقها من العبودية التاجر اليهودي الذي اتخذها خليلة له، لتتمكن أخيراً من تحقيق حلم العودة إلى جزيرتها الأم في منطقة الكاريبي، إلا أن قدرها المنكود كان يهيئ لها نهاية أكثر قتامة. فقد أدى انضمامها إلى ثورة العبيد الآبقين في تلك الفترة إلى أن تقضي مع عشيقها الجديد برصاص الأسياد البيض، لتتحول بذلك إلى واحدة من الأساطير المؤسسة لمناهضة التمييز العنصري والنضال من أجل الحرية.
لست متيقناً، إذا كانت الكاتبة التركية أليف شافاك قرأت رواية ماريز كوندي التي سبقت عملها الأخير «10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب» بأكثر من ثلاثين عاماً، أم لم تفعل. لكن هذا السؤال لا يتم طرحه من باب الفضول المجرد، بل بسبب التشابه الغريب في «تقنية» السرد الروائي الذي تتولاه في صيغة أنا المتكلم امرأتان مقتولتان، بما يضيف إلى مقولة الراوي «كلي القدرة» قدرات إعجازية أخرى تمكّنه من عبور الجدار الفاصل بين الحياة والموت. وكما تحولت تيتوبا إلى رمز لروح السلالة السوداء في نزوعها الأبدي إلى الانعتاق، تحولت ليلى تيكيلا، بطلة شافاك الجديدة إلى مجسد مماثل لروح إسطنبول التي تبحث عن خلاصها عبر إرساء قيم العدالة والحرية والمساواة بين البشر. أما الذريعة الروائية التي ابتكرتها شافاك لتمكين بطلتها المقتولة من تولي مهمة السرد، فهي افتراضها أن دماغ المرأة المقتولة والملقاة في حاوية النفايات، لا يزال قادراً أن يعمل لدقائق عشر إضافية، رغم توقف قلبها عن الخفقان. ومن خلال ذلك البرزخ الأخير الفاصل بين الحياة والموت. تستعرض المرأة الأربعينية المقتولة حياتها كاملة، منذ ولادتها في قرية تركية نائية، وحتى فرارها من منزلها العائلي لتستقر في المدينة الساحرة والقاسية والحافلة بالتناقضات، التي جعلتها شافاك المكان الأثير لمعظم أعمالها الروائية.
ومع أن شافاك قد عُرفت من قبل بجرأتها البالغة التي كلفتها الابتعاد شبه القسري عن وطنها الأم، إلا أنها تتجاوز في روايتها الأخيرة مختلف الخطوط الحمراء التي تفرضها المجتمعات الشرقية على كتابها وكاتباتها. إذ ليس من السهل على صاحبة «لقيطة إسطنبول» أن تختار امرأة تعمل في الدعارة بطلة لروايتها، حتى لو جهدت على لسان بطلتها في استعادة كل الظروف القاهرة التي دفعت البطلة إلى الوقوع في شرك الانحراف، ابتداء من إلحاقها القسري بأمّ أخرى، مروراً بانتهاك عمها الفظ لبراءتها الطفولية، وليس انتهاء بوفاة شقيقها «المنغولي»، وانعطافة أبيها المفاجئة نحو التيار الديني المتشدد، وما تبعه من محاولات قهرها والتحكم بمصيرها. لا تنتهي الرواية بمقتل ليلى المأساوي في إطار سلسلة من عمليات القتل المماثلة التي يأمر بها أحد الأثرياء النافذين، كتعبير عن سخطه البالغ على مثلية ابنه الشاب، بل ثمة فصل آخر تفاجئ به شافاك قراءها من خلال تصميم أصدقاء ليلى الخمسة على إخراج جثتها من مقبرة الغرباء، ومن ثم دفنها قرب حبيبها الماركسي الذي قتل في إحدى تظاهرات اليسار الصاخبة ضد السلطة الحاكمة، في سبعينات القرن الفائت. وليس من قبيل الصدفة بالطبع أن يكون الأصدقاء الخمسة بمجملهم من المهمشين والمرذولين والمتحولين جنسياً، والمقيمين في حزام المدينة الفقير. ذلك أن هدف الرواية في الأساس كان البحث عن القاع الإنساني المقهور للمدينة العريقة التي تحاول أن تخفي وجهها البائس خلف أبراجها الشاهقة وفنادقها الفخمة وأحيائها الباذخة الجاذبة لملايين السياح. وإذا كان ثمة من تشابه واضح بين كلّ من عملي ماريز كوندي وأليف شافاك، من حيث تقنية استنطاق الموتى، والتركيز بتأثير فرويدي واضح على ثنائية الجنس والموت، والبعد الملحمي للسرد وتوظيف العمل الروائي في إعادة كتابة التاريخ الحقيقي للمجتمعات والفئات المقهورة، فإن الفصل الأخير من رواية شافاك لا بد أن يحيل القارئ إلى تقاطع آخر مع رواية جورج أمادو «كانكان العوام الذي مات مرتين». ليس فقط من خلال رغبة أصدقاء البطل المتوفى في كلتا الروايتين في الاحتفاظ بجثته أطول وقت ممكن، بل من خلال تشابه النهايات، حيث يتم رمي العجوز المتوفى في مجرى النهر، بينما يتم رمي المرأة المقتولة في مياه البوسفور.
أما الكاتبة التشيلية إيزابيل ألليندي، فتستكمل من خلال روايتها الأخيرة «سفينة نيرودا» مشروعها الروائي المميز الذي يربط بين تاريخ التشيلي الحديث وبين مصائر أبطالها المنعطفة بشكل دراماتيكي، وبتأثير من أنظمة الاستبداد، نحو مآلات غير متوقعة... ألليندي صاحبة «بيت الأرواح» التي اتخذت من الحادثة المأساوية التي تعرضت لها مع ابنتها باولا الذريعة الملائمة لعرض تاريخ بلادها على الابنة الواقعة في الغيبوبة، عثرت على ضالتها هذه المرة، من خلال السفينة التي أعدّها بابلو نيرودا لنقل الثوار الإسبان الناجين من مذابح فرانكو إلى بلاده التشيلي، متمكنة من خلال هذه الرحلة الغريبة للسفينة التي نقلت ألفي لاجئ إسباني، أن تستعيد فصولاً مرعبة من الحرب الأهلية الإسبانية التي انتهت بانتصار الفاشية العسكرية. بينما يتمحور الصراع بشكل أساسي حول شخصية الطبيب الإسباني فكتور دالماو، وروز عازفة البيانو زوجة أخيه الحامل الذي قتل في الحرب، واضطر للزواج منها لأسباب عملية تتعلق بشروط الرحلة نفسها، وإنسانية تستوجب حمايتها مع الجنين. لكن الطبيب والعازفة سيحتاجان بعد الإقامة في التشيلي لسنوات عدة كي يتحولا إلى زوجين حقيقيين ومتحابين. كما سيختبر كل منهما علاقة عاطفية أخرى، تتجاوزها روز بأقل الأثمان، فيما يواجه فكتور في علاقته العابرة بالفتاة الثرية أوفيليا دي ظروفاً أصعب تنتهي بافتراقهما الحتمي، وإنجاب أوفيليا مولودة أنثى، لن يتعرف إليها الأب إلا في نهاية الرواية. وخلال ذلك سيتعرف فكتور على سلفادور ألليندي، عم المؤلفة الحقيقي، الذي سيتسلم رئاسة تشيلي بعد سنوات، وسيكتب عليه أن يشهد مرة أخرى انقلاباً دموياً آخر يقوم به العسكريون بقيادة بينوشيه، وبتحريض ودعم أميركيين، وسيزج به في السجن بحجة علاقته بالرئيس المقتول. يتمكن فيكتور مع زوجته من الفرار إلى فنزويلا لسنوات، قبل أن يقررا العودة إلى إسبانيا مرة أخرى، ليكتشفا أن لا مكان لهما هناك، بعد أن أحكم فرانكو قبضته الحديدية على البلد المنكوب. وكان قدر الزوجين أن يعودا في النهاية إلى تشيلي، حيث الوطن والمنفى يتبادلان الأدوار، ثم يمكثان هناك حتى الرمق الأخير.
في الختام، ثلاث كاتبات أرهفن السمع لتاريخ شعوبهن، وما يتمخض عنه من تحولات اجتماعية وفكرية وسياسية. ورغم اختلاف المقاربة والأسلوب، استطعن أن يكن حفيدات شهرزاد المنصهرات بروح أوطانهن الأم.
المصدر: الشرق الأوسط