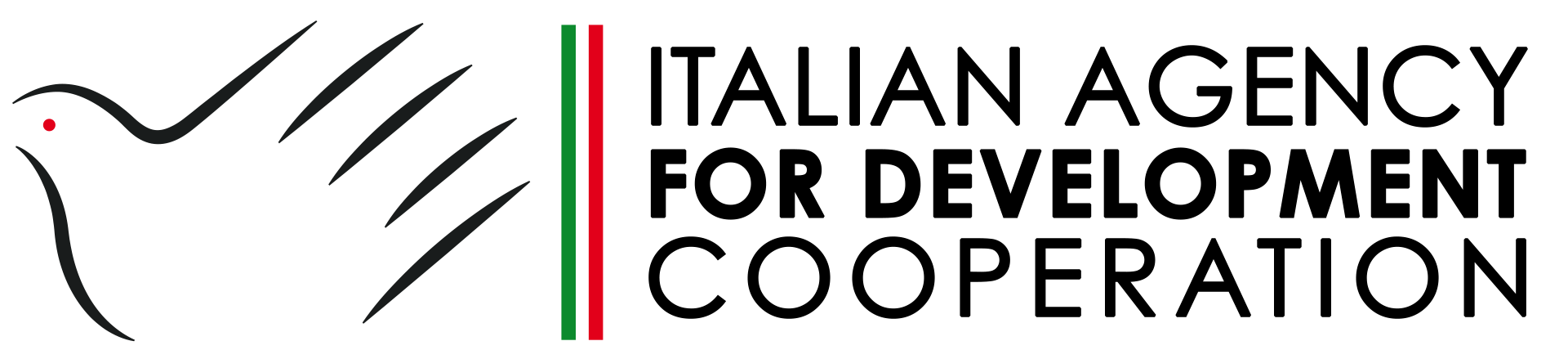"مجلة جنى" - في كل صباح أقطع الخطى إلى الشارع العام، حيث يكتظ بضجة أبواق السيارات وهي تشق طريقها في وسط الزحام مع أفواه تصارع لذة التثاؤب الصباحي ووجوه أخرى يعانقها الخمول، وهمّة بائعي الجرائد وعمال النظافة بزيهم البرتقالي ونسبة شحيحة من أصحاب بعض المحال التي تفتح دكاكينها في بكرة شروق الشمس، وأصحاب المقاهي الذين عهدتهم مذ بدأت أمارس نشاطي هذا في الصباح بعد ما طلبت مني أمي ذلك .. تقول إنها تخاف عليّ من لصوص الليل ومن بعض السكارى والشاذين في الطرق المدلهمة .. أربض أمام إحدى السيارات من نوع ” لاند كروزر “.. كم أعشق أنواع هذه السيارات التي تشي مظهرها بالعلو والفخامة، وكم أحلم أن أقعد في أحد مقاعدها يوما ما .. هكذا كنت أحدّث أختي حليمة وفي كل مرة كانت ترمقني بنظرتها التي لا تخلو من العجرفة والقسوة وتسكتني بلغتها التشاؤمية .. صاحب السيارة ذو وجه بشوش ينتعل نظارة طبية بعدسات دائرية تلاءم أرنبة أنفه الطويل .. أزاحم الخطى خشية أن تظهر الإشارة الخضراء، أصل إليه بأنفاس لاهثة، وأنقر على زجاج نافذته اللامعة جداً حتى أنني أرى انعكاس صورتي عليها وصور بعض المارة من خلفي، يلتفت نحوي، يشير إلى هاتفه النقال .. انتظر وعيني على ساعته الذهبية باهظة الثمن .. وأمنّي نفسي بأحلام اليقظة بامتلاك ساعة توفر عليّ عناء معرفة الوقت بالضبط في كل مرة أخرج فيها.
ينفقئ خيالي على صوت بائع الجرائد وهو يزيحني بقوة عن زجاج النافذة ويعرض جريدته على صاحب ” اللاند كروزر “، يستلم الجريدة وينقد البائع وعندما أقف بدوري بالقرب من النافذة المشرعة تزعق أبواق السيارات من خلفه فتمرق السيارة مسرعة مع الإشارة الخضراء .. أرتدّ قافلة بيأس إلى حيث كنت على الرصيف، أتأفف من يومي وألعن صباحي، وعندما أعود إلى البيت أشكي لأمي سوء الحال .. فترفع معنوياتي بكلماتها اللطيفة وتقول إنني لم أعتد بعد على العمل الصباحي بعد التبادل في الفترات الذي حصل بيني وأختي الكبرى حليمة التي كانت تتذمر من الاستيقاظ مبكراً .. وعندما تعود أختي من نوبتها المسائية تغيظني بعجرفتها وبكسبها الوفير، وتعلن بغرور إنها حين كانت تكد في الصباح كانت كسبها يدرّ، فتتهمني بالخمول وتنعتني بالغبية.
أمي تفضي النزاع بيننا عندما تضع مخلفات الأطعمة الشهية التي تحضرها من بيت العمة “شيخه”، وهي امرأة رزقها الله بوفرة المال والرزق، وتعمل عندها أمي منذ أكثر من شهرين كخادمة تكنس وتطهو لهم، وكل ما يفيض عن حاجتهم من الطعام تسمح لأمي بإحضاره لنا .. ونحن كل مرة نترقب بصبر حفلات أعياد الميلاد ومناسبات أخرى كي نتذوق أشهى الموائد.
بعد الظهيرة ترسلني أمي إلى دورة تحفيظ القرآن في المسجد القريب لحيّنا، حيث يجتمع جوقة من الصبية والفتيات الذين كنت أصادفهم أثناء العمل سواء في الأمسيات التي كنت أعمل بها أو في أصبوحات أيامي وهم يمرقون مثلي من سيارة إلى سيارة بثيابهم المرقعة والباهتة. كانت أمي لا تعي بتعليمي مطلقا وتكرر دائماً أن الشهادات ليست مهمة والكسب باليد أفضل، ولكن عندما علمت أن هذه الحلقات تخصص في نهاية حفظ كل جزء من القرآن مبلغا نقديا قيّما ، حرصت من خلاله على مواظبة إرسالي، وكذلك فعلن أمهات بقية الصبية والفتيات.
كنت في البداية أضجر من هذه الحلقات ولكنني تأقلمت مع الوضع تماماً والمبلغ حفزني أكثر على الحفظ. فقد كنت أردد كل ما يلقنّه “المطوع” على مسامعنا أثناء قيامي بعملي صباحاً بين السيارات وفي المساجد أو حتى بين المحلات التجارية حيث يتجمهر الناس للشراء، وفي مواسم الأعياد كان المطوع يحرص على تسليم كل منّا مظروفاً خاصاً نسلمه ليد – وليّ الأمر- كما كان ينبّهنا في كل مرة يضع هذه المظاريف في أكفّنا الصغيرة. عندما سلمت أمي المظروف، انفرجت أساريرها قبل حتى أن تفتحه.
انكفأت أمي في أيام العيد على أن تلبسني ثياباً عتيقة ومرقعة في أكثر من موضع، فأشبه ما أكون فيها كفزاع رثّ وسط مزرعة خصيبة. تعلل فعلها بأن ذلك يجعل الجيوب الجافة طرية والنفوس الشحيحة سخية، وقد كان قولها صائباً فمجرد وقوفي على الرصيف، قٌدمت لي عدة أوراق نقدية من فئة خمسة وعشرة دراهم، و قلّ ما يحدث ذلك في الأيام العادية.
يمرق من أمامي أطفال في ثياب جديدة ناصعة، وتحمل الفتيات مثيلاتي في السن حقائب يدوية مزركشة تتماثل مع ألوان ملابسهن الأنيقة ومع لون الحذاء والإكسسوار كذلك. إحداهن ترمقني بنظرة غريبة فتتهامس مع زميلاتها ثم يخطين نحوي أسراباً من الفراشات زاهية الألوان، أنظر إلى ثيابي الرثة فأخجل من نفسي وأتمنى لو أن جريت بعيدة عنهن..أشعر وكأنهن يلتهمنني بضحكاتهن الساخرة ويحتقرنني بملابسهن الجديدة، فأتقهقر بخطواتي إلى الوراء، غير أن إحداهن تستوقفني عندما تهتف باسمي : ” خديجة “،و تكرره على مسمع من الجميع:” خديجة .. خديجة “، وتضيف بصوتها الناعم : ” ألم تتعرفيّ عليّ، أنا ” نوف “. فأتذكر أنها إحدى حفيدات العمة “شيخه”، تلك العجوز الغنية التي تعمل عندها أمي، فيتسع فضاء ذاكرتي وأتذكر أنها هي من أهدتني مصحف القرآن الكريم حين اصطحبتني أمي لزيارتهم في بيتهم وعندما علمت أنني التحقت بحلقة الحفظ ولا أملك مصحفاً خاصاً بي.
أتذكر تلك التفاصيل التي تتلاشى بمجرد وقع الدراهم المعدنية اللامعة وهن يسقطنها الواحدة تلوى الأخرى في الكيس الذي أحمله، وعادة لا انبس بشيء، فقط أنقر على زجاج السيارة .. بعضهم يعطيني المال بمجرد ما يلقي نظرة خاطفة على وجهي الشاحب وعيني المصفرتين من الداخل، وفئة لا تقدم لي شيئاً لكنها لا تبخل عليّ بابتسامة تخفي خلفها نوعاً من الشفقة، وفئة أخرى وما أكثرهم أولئك الذين إضافة إلى شحّهم، فإنهم يكيلون عليّ بأفظع أنواع الشتائم واللعان دون أن أعلم مبعث غضبهم عليّ.
ثمة وجوه تعودت عليّ كالعم “صالح”، صاحب إحدى المقاهي الشعبية، فكثيراً ما كان يربت بحنو على رأسي ويقدم لي قرصاً ساخناً مدهوناً بالعسل اللذيذ، كالذي كانت أمي تعجنه لنا عندما يتوفر الطحين الذي توزعه الجمعيات الخيرية، فتنثر عليه حبّات السكر عوضاً عن العسل، الذي تذوقته لأول مرة في مقهى عم صالح.
لكنني أمقت تلك الأيام التي يغيب فيها العم صالح وينوب عنه شقيقه سلطان، وهو رجل ضخم البنية ووجه يميل إلى الاسمرار مع حَول في عينه اليمنى .. فكثيراً ما كان يخيفني بصوته المنذر بالشرطة إذا ما وقفت أمام المقهى، فترتجف أوصالي من لفظة الشرطة كما لو كنت أشاهد فيلما مرعبا.. خاصة بعدما وقع لـ”عادل” الذي سمعت بقصته من أفواه بعض الصبية في حلقة الدرس، أنه في أثناء قيامه بعمله في أحد الأيام أمسك به صاحب إحدى السيارات من عنقه وسلمه للشرطة بعد ما كان يعترض طريقه في كل يوم يذهب فيه إلى دوامه الصباحي، فزج به في الحبس لزمن ليس بقصير وبعد خروجه أصبح يمارس عمله بحذر مساءاً بالقرب من دور السينما والفنادق والملاهي الليلية حيث يغدق بعض السكارى بكرم .. أحيانا أتخيل كل رجل في سيارته رجل شرطة، وكثيراً ما يكونوا ضيوفاً على كوابيسي، فتضطر أمي إلى التخفيف من روعي، وتطمئنني أن ما أتعرض له نتيجة تخيلاتي الواسعة لا أكثر .
أتعلم من أمي كثيراً وأنفّذ كل ما تطلبه مني بحذافيره، فقد بدأت بهذه المهنة في سن مبكرة من عمرها وكانت تحملني في حضنها وأنا رضيعة، تعبر بي من بيت إلى بيت وهي تدمع أحيانا وترتجف شفتاها في أحايين أخرى، وكانت بعض الأبواب ترحب مشفقة وأخرى توصد بقسوة في وجوهنا، و في ليالي الشتاء القارصة كنت أبكي حين تلفح الريح الباردة عظامنا بأسمالنا الرقيقة البالية، وكانت أمي تجرني من يدي أنا وأختي حليمة، وكنا نلتصق بعباءتها الرثة ردعاً للبرد وخوفاً من بعض قاطعي الطرق الذين كانوا يرشقوننا بنظراتهم الحادة.
بعد مرور سنوات غدت كل واحدة منّا تسلك طريقاً مختلفاً تشير عليه أمي، بعد أن تلقينا منها الدروس وبعد التدريب الذي خصصته لنا أسابيع عدة كي نتعود ونتقن المهنة، وتلتقي ظلالنا عند نقطة الانطلاق، فنضم أنا وأختي حليمة ما نكسبه من مال إلى كيس أمي .. و بعد إصابتها بالروماتيزم والتحاقها للعمل في بيت العمة شيخه، أضحينا أنا وأختي حليمة نتناوب على العمل بين الليل والنهار دون أن تضمنا بقعة واحدة أو التوقيت نفسه؛ لأننا كثيراً ما كنّا نتشاجر في وسط الطريق أو نتنازع على أولوية الوقوف عند سيارة ما تمرق من أمامنا، وكثيراً ما كنا نتشاءم من الأيام التي يتوشح أفقها بغيوم رمادية حالكة تنذر عن أمطار وعواصف .. حيث تتصارع السيارات للخروج بعصبية من برك الوحل في الشوارع الرملية ومن المياه الطافحة في الشوارع المعبدة، وكنت كثيرا ما أمنّي أمي بأن تسمح لي بأن أرتدي المعطف الذي يقي من المطر والبرد .. لكنها كانت تتذمر من ذلك وترفض الفكرة وترى أن أحداً لن يتصّدق عليّ بدرهم واحد؛ فالمعطف غالي الثمن قدمته لنا العمة شيخه كان لإحدى حفيداتها وقد دُهشنا أنا وأختي حليمة من ملمسه الناعم ونظافته وكأنه لم يعلّق على كتف يوما ما! .. ولكن عندما تصفعني الحمى ويتعطل العمل، تتذمر أمي وتردد بحسرة لأختي حليمة:” لو أنني سمحت لها بارتداء المعطف لما نهشتها الحمى”، وحين كنت أستعيد وعيي للعمل، أشق دربي كنحلة من سيارة إلى سيارة، وأحرص على تعويض أمي عن الأيام التي سقطت بها في فخ الحمى. ولا أنكر أنني كنت احترق من الغيرة عندما أسمع أمي تحوط أختي حليمة بكلمات إطراء عن نشاطها وكسبها الوفير دوماً.
في ظهيرة ما حين عدت إلى المنزل للغداء، وضعت كل ما جمعته في كف أمي وكانت سعيدة بكسبي ونعتتني بالصفات نفسها التي كانت تصف بها أختي حليمة، وكمكافأة على نشاطي وضعت أمامي علبة عامرة بالكعك اللذيذ؛ أحضرته من بيت العمة شيخه التي أقامت حفلاً بمناسبة نجاح إحدى حفيداتها في المدرسة، بعدما طلبت مني أن أترك حصة أختي حليمة منها، وكان منقار الجوع يثقبني فالتهمت حصتي وبعدما تأخرت أختي في المجيء مددت يدي إلى قطعة أخرى من حصتها، وعندما سمعت نقراً على الباب وضعت العلبة جانباً؛ كي لا تهجم عليّ أختي حليمة حين تعلم بأنني استوليت على قطعتها من الكعك.
ولكن القادم لم يكن أختي، بل كان رجلاً يرتدي ملابس الشرطة وحين رأيته اختبأت خلف أمي بوجل كي لا يراني، كذلك غلب الهلع على أمي التي ذابت ملامحها بمجرد رؤيته. سأل الشرطي عن والدي فأخبرته أمي بحزن أنه متوفى، فأخبرها الشرطي بأسى بأن أختي حليمة لحقت به بعدما دهستها شاحنة محملة بالبضائع وهي تقطع الطريق إلى إحدى السيارات في الطريق العام وقد تناثرت شظايا.
بعد صدمة وفاة أختي حليمة تحطمت كينونة أمي، وحاولت أن أسعدها بالكدح ليل نهار في الشوارع العامة والمحال التجارية وبين الأزّقة والمساجد؛ فتركت حلقات الحفظ لأن ما كنت اكسبه يفوق المبلغ أضعافا، خاصة في شهر رمضان الكريم وموسمي العيد. وفي إحدى نوبات العمل انتصبت بوجهي الكسير عند إحدى السيارات الفارهة، نوافذها كلها مطلية باللون الأسود، مددت كفي ككل مرة غير أنني صعقت عندما وقع نظري على شابة كانت تشبه أختي حليمة ولكنها في ثياب أنيقة ونظيفة جداً، وإلى جوارها الرجل الذي كان يشبه الشرطي الذي أخبرنا بموتها. رشقتني أختي بنظرات غريبة، أدركت منها أنها تريدنا أن نمحوها تماماً من سجل حياتنا وأن نعدّها ميتة كما شيع عنها. ونسيت أمرها عندما نقدني صاحب إحدى السيارات المارقة من خلفهم، عشرة دراهم، وعندما عدت للبيت لم أخبر أمي عنها ولم أصادف سيارتهم بعد ذلك مطلقاً.
بقلم: ليلى البلوشي - قاصة من سلطنة عمان تعمل في الإمارات
المصدر: ثقافات