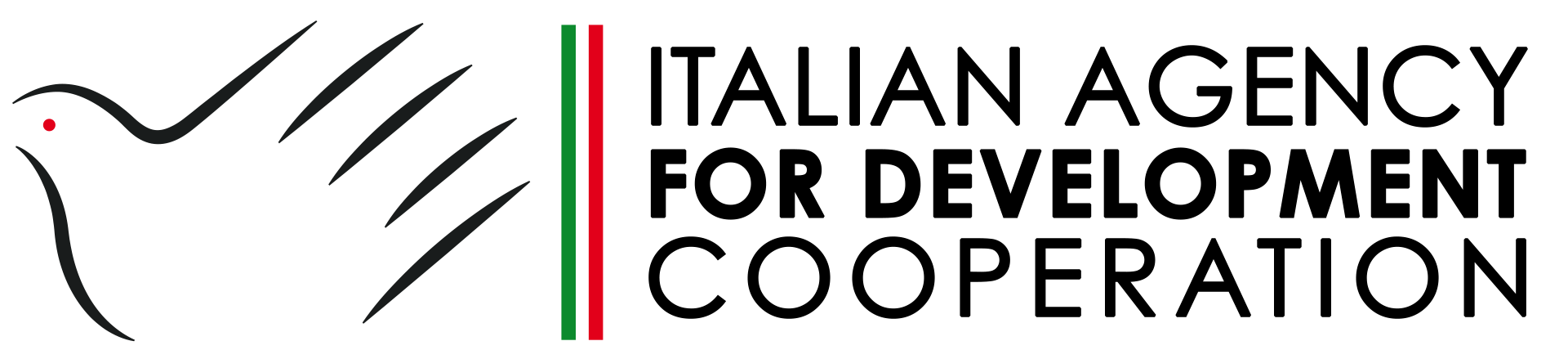الطفل إبراهيم المصري، 10 أعوام، يجلس وسط حطام منزله في بيت حانون، قطاع غزّة
"مجلة جنى" - "في ظلّ هذه الظروف العصيبة"؛ تحوّلت هذه العبارة إلى مقدّمة ترويجيّة لإعلان توفّر خدمات نفسيّة في فلسطين، تضخّ نصائح للحماية من القلق والاكتئاب والصدمة، والمحافظة على التوازن الداخليّ. لا شكّ في أنّ هذا ضروريّ وحيويّ، ولكن إذا انحصرت مهمّة علم النفس بالعلاج فإنّه يمكن أن يصبح مجرّد تخفيف يساهم في تمديد الوضع الّذي يولّد الآلام الّتي يسعى إلى علاجها؛ فالحديث عن طرق للاحتماء ممّا يحدث يعني أنّنا نبني حاجزًا فاصلًا بيننا وبينه، بدلًا من إيجاد صلات معه ومعرفة مواقعنا منه؛ الأمر الّذي يتطلّب بناء خطاب يبتعد عن توجّه النجاة الفرديّة للضحيّة الّتي ليس لديها حيلة أمام الصدمة والإذلال.
غالبًا ما تحجب التدخّلات النفسيّة سياق الاستعمار والنضال ضدّ سياساته؛ في محاولة للحفاظ على الحياديّة، ويتحوّل العنف السياسيّ الّذي يمارسه الاستعمار إلى معاناة فرديّة يجب التغلّب عليها، من خلال تمكين الذات.
تحاول هذه المقالة تحليل مفهوم "الصدمة" في سياق الاستعمار، وتحديدًا الحروب، والأخيرة حالة ذات ديمومة في فلسطين والمنطقة، آخرها الحاصل الآن إزاء قطاع غزّة وغيرها من مواقع.
الصدمة تحت الاستعمار
أظهرت دراسة أُجْرِيت في الضفّة الغربيّة الشماليّة من عام 2010 إلى عام 2012، لفحص جهود إغاثة الصدمات في نابلس ومخيّمات اللاجئين المحيطة بها؛ تجنّبًا مماثلًا لاستخدام لغة الاستعمار والنضال. على سبيل المثال، في النداءات للمانحين وطلبات تمويل المشروع، غالبًا ما استُخْدِمت الاستعارات مثل "العنف السابق والجاري"، أو "العنف والصدمة"، بدلًا من الإشارة المباشرة إلى سياق الاحتلال. إضافة إلى ذلك، سعت مثل هذه المشاريع غالبًا إلى محاكاة مفاهيم الإنتاجيّة، والتعبير عن الذات، والثقة بالنفس؛ ممّا يشير إلى التركيز على الشفاء الفرديّ والتنمية الشخصيّة، بدلًا من الانتعاش الجماعيّ والصمود والنضال.تزيل مثل هذه الخطابات الجوانب
عن الاستمعار، محوّلةً إيّاه إلى مجموعة من العقبات التنمويّة الشخصيّة الّتي يجب التغلّب عليها من خلال التأمّل الشخصيّ، بدلًا من التفكير بالاستعمار بوصفه عنفًا منهجيًّا موجّهًا نحو المجتمع الفلسطينيّ، يتطلّب حلًّا سياسيًّا لمعالجته؛ فالتعامل مع المشاعر بوصفها عوامل متطايرة ليس لها بنية تحتيّة، إنّما هو منطق نيوليبراليّ؛ ففي حين نغرق في خطابات حول السعادة الفرديّة والاستمتاع والإنجاز في حالة اللاحرب؛ فإنّنا في حالة الحرب نغرق في نصائح حول النجاة الفرديّة. وفي كلتا الحالتين يُتَعامَل مع الفرد بصفته بنية منسلخة عن سياقها الطبقيّ والسياسيّ.
في كتاب «معذّبو الأرض» (1961)، يقدّم فرانز فانون (1925-1961) تحليلًا نفسيًّا للاستعمار. أحد جوانب هذا التحليل يتضمّن نقدًا لعلم النفس بوصفه أداةً للاستعمار؛ إذ يكتب عن مستشفيات الطبّ النفسيّ الّتي تعاملت مع مقاومة الاستعمار الفرنسيّ بوصفها شكل من أشكال الجنون الّتي في حاجة إلى العلاج؛ فكيف، إذن، يمكن الاستناد إلى علم متورّط في الاستعمار في حلّ مشاكل نفسيّة ناتجة عنه؟
هذا يؤكّد لنا أنّ الاستعمار الاستيطانيّ بالضرورة ينتهج أدوات استعماريّة نفسيّة غير تلك العسكريّة؛ بهدف تجريد العلاقة الاستعماريّة من صفتها الاستعماريّة، ومحو الهويّة والحضارة الخاصّة للسكّان الأصليّين. يرى نغوكي واثينغو بأنّ الهدف الحقيقيّ للاستعمار يكمن في السيطرة على العالم الكامل للغة الحياة الحقيقيّة، وأنّ الجانب الأكثر أهمّيّة للاستعمار هو العالم الذهنيّ للمستعمَرْ، الّذي يتمثّل في الثقافة الّتي تحدّد رؤيته لذاته وللعالم. السيطرة على الاقتصاد والسياسة لا يمكن أن يحقّقا الهدف الكولونياليّ، دون السيطرة على الأدوات الّتي يتعرّف فيها الإنسان ذاته تجاه الآخرين.
علم النفس أداةً للتحقير
في مقال «طبقات الاستعمار في أفريقيا» (Stages of colonialism in Africa)، يتحدّث حسين بولهان عن التواطؤ بين علم النفس الكلاسيكيّ والبنية الاستعماريّة؛ إذ شرع علماء النفس والأطبّاء النفسيّون في فترة الاستعمار في إجراء مقارنات ذات بُعْد عرقيّ بحجم الدماغ، واستنتجوا من القياسات المنحازة بطبيعتها أنّ الأفارقة ينتمون إلى مرحلة تطوّريّة أقلّ، ودرسوا معدّل الذكاء المرتبط بثقافتهم، وأكّدوا أنّ الأفارقة وذرّيّتهم يُظْهِرون ذكاء أقلّ مقارنة بالأوروبّيّين.
تبرّر هذه البنى المعرفيّة الاستعمار الأوروبّيّ لغير الأوروبّيّين، وربّما تهدّئ الضمير المضطرب للأوروبّيّين بشأن العنف الاستعماريّ. ولم تنتهِ مساهمة علماء النفس والأطبّاء النفسيّين في تبرير الاستعمار؛ فبعد عام 1960 عندما حصلت العديد من الدول الأفريقيّة على استقلالها عن الدول الاستعماريّة، تحوّلت الأدبيّات النفسيّة الأوروبّيّة والطبّ النفسيّ، من التأكيد على أنّ الأفارقة غير أكفياء بالفطرة إلى التأكيد على زيادة معدّلات القلق والاكتئاب الجماعيّ والاضطرابات النفسيّة بينهم؛ وهذا يشير إلى الادّعاءات السابقة بأنّ ’العبيد السود‘ كانوا غير قادرين بالفطرة على العيش بحرّيّة، أو على الأقلّ بدون سيّد أبيض. على الرغم من تاريخ تورّط علم النفس بتبرير الاستعمار، غالبًا ما يُظْهِر علماء النفس والأطبّاء النفسيّون فقدان ذاكرة جماعيًّا، متجاهلين تواطؤهم مع الاستعمار بأشكاله الفجّة.
إنّ إسقاط علم النفس الغربيّ على سياقات مختلفة ضَرْب من السطحيّة؛ لما هناك من اختلافات كبيرة بين هذه السياقات. في الفيلم الوثائقيّ «XANAX» (2021) تتحدّث طبيبة نفسيّة عن تجربتها في علاج رجل أسود، وتقول إنّه خلال حديث عابر قال إنّه رأى شخصًا يُقْتَل أمامه؛ فقاطعت كلامه لأنّها حين أعطته يعبّئ استبانة في الجلسة الأولى لهما لمعاينة حالته، أجاب بــ "لا" عن سؤال: "هل تعرّضت لموقف صادم في حياتك؟"؛ الأمر الّذي جعل الطبيبة النفسيّة تستغرب بأنّه لا يعتبر هذا الموقف صادمًا، واكتشفت حينذاك أنّ الاستبانة وطريقة صياغة الأسئلة غير ملائمة لسياق الرجال السود. فضلًا على أنّ مفهوم الصدمة يختلف من شخص إلى آخر، تبعًا للبيئة الّتي ينتمي إليها؛ فعلم النفس الغربيّ يختزل ردّ فعل الشخص تجاه مجموعة معقّدة من الظروف السلبيّة، مثل الفقر والبطالة والتشرّد والتعذيب والاستعمار، إلى مجرّد تشخيص طبّيّ يُدْعى ’الاكتئاب‘، يُعالَج بشكل فرديّ، متجاهلًا ضرورة إصلاح البيئة وتغييرها، الّتي هي في الأساس المسبّب الرئيسيّ للاكتئاب، بوسائل ذات طابع اجتماعيّ، وسياسيّ، واقتصاديّ.
بهذا؛ يُحَوَّر الطبّ النفسيّ في الولايات المتّحدة وبلدان أخرى من العالم إلى مهنة، تفرض داخلها مفاهيم طبّيّة ضيّقة في تشخيص الاكتئاب وعلاجه، ويُسْلَب الألم من أيّ معنًى له، والغاية هي القضاء عليه تمامًا.
الصدمة في علم النفس التحرّريّ
وفقًا لمارتين بارو، لا تكفي دراسة تأثيرات الصدمة والاكتئاب والقلق، بل يجب توجيه الاهتمام نحو الظروف الّتي تسمح لها بالاستمرار. هذا ما يسمّيه مارتين بارو بـ ’البنية الصادمة‘ أو ’الظروف الاجتماعيّة‘، مثل الاستغلال والقمع والاستعمار، الّتي تصبح ’غرابة طبيعيّة‘. وبالتالي، فإنّ المهمّة العاجلة لعلماء النفس الّذين يسعون نحو التحرّر هي دراسة هذه العلاقات المقهورة، وأداء دور في المشروع السياسيّ الجماعيّ لتغييرها. فالطريقة الّتي وُظِّفَ فيها علم النفس لتبرير وتمكين المشروع الاستعماريّ الأوروبّيّ يتطلب تطوير علم النفس المضادّ من وجهة نظر المضطهدين. ففي حين اعتقد فانون أنّ النضال العنفيّ والمضادّ للاستعمار هو السبيل الوحيد إلى التحرّر النفسيّ والاجتماعيّ، اعتقد أحد تلاميذه، وهو التربويّ البرازيليّ باولو فريري (1921-1997)، أنّ التحرّر للمضطهدين يمكن تحقيقه من خلال الفحص الذاتيّ النقديّ ورفع الوعي، أو ما يُعْرَف بـ ’الوعي‘. هذا المفهوم لرفع الوعي النقديّ هو في قلب تربية المضطهدين لفريري، وكذلك مشروع اجتماعيّ ومعرفيّ متحالف في أمريكا اللاتينيّة - وهو علم النفس التحرّريّ.
يرتبط علم النفس التحرّريّ ارتباطًا وثيقًا بعلم النفس الأصلانيّ، وعلم النفس المناهض للاستعمار، وعلم النفس النسويّ، وعلم النفس النقديّ الّذي يهدف في مجمله إلى تحويل علم النفس إلى نهج تحرّريّ، اجتماعيّ ونقديّ، يسعى إلى العدالة الاجتماعيّة، أو يقاوم الوضع الراهن، ويفهم القضايا النفسيّة كما تحدث في سياقات سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة تاريخيّة معيّنة. إذ يستجيب علماء النفس النقديّين لاستيراد نماذج نفسيّة غربيّة سائدة دون تمييز، ويسعون إلى تعزيز فهمهم الخاصّ، وسبل التعامل مع جروح الحروب. الوعي النقديّ، أو العمليّة الحواريّة للتفكير والعمل، الّتي تساعد على تطوير الوعي النقديّ والشعور بالفاعليّة، يتطلّبها علم النفس التحرّريّ، كما وصفها مارتين بارو، في ثلاثة مشاريع ذات صلة: أوّلًا: يجب أن يشارك الناس في تحويل واقعهم - وهو عمليّة تكون من خلال الحوار. ثانيًا: يجب على الناس أن يفهموا آليّات القمع واللا أنسنة، وبالتالي بناء الوعي النقديّ وتعزيز إمكانيّة فهم بديل للعالم. ثالثًا: الفهم الجديد الّذي يُبْنى من خلال هذه العمليّات يؤدّي إلى شعور متجدّد بالذات والفاعليّة.
وعليه، تتطلّب ممارسات علم النفس التحرّريّ التكريم ومحاولة الاستخلاص لتفاهمات الأشخاص للسياقات السياسيّة والتاريخيّة للمعاناة، وهذا ما نحن في حاجةِ إليه في "هذه الأيّام العصيبة". نحن في حاجة إلى إعادة تأطير وإعادة تحديد معاني الألم، واستعادة مكان الفرد في المجتمع. علمًا أنّ اعتماد مثل هذا الموقف قد يتطلّب من الممارسين اتّخاذ جانب في الصراع، متجاوزين بذلك وَهْم الحياديّة، وهو ما يؤمن به علم النفس التحرّريّ الّذي طُبِّق لفهم تأثيرات العنف السياسيّ والقمع، واستجاباته في سياقات متنوّعة، بما في ذلك كولومبيا وإيرلندا الشماليّة ضمن إطار النضال من أجل التحرّر.
يجب علينا أن نتذكّر أنّ الأفراد ليسوا ضحايا ساكنين في بيئتهم، بل لديهم أيضًا وكالة سياسيّة ووعي اجتماعيّ، والاعتراف بقدرتهم على التعافي النشط، وتغيير الواقع المادّيّ، يتوافق مع إطار متجذّر في الماركسيّة الّتي تجادل بأنّ الصحّة النفسيّة لا يمكن أن تتحقّق بالكامل، إلّا في مجتمع خالٍ من الاستغلال والقمع. فبدلًا من حثّنا على تغيير الطريقة الّتي نرى بها العالم، جادل الماركسيّون الجذريّون بأنّ عالمًا آخر ممكن، وأنّ هذا الانفتاح على الممكن هو المعنى الكامن خلف أيّ ألم أو وجع أو فقد. وأيّ خطوة في أرشيف النشاط السياسيّ هي خطوة للتحرّر النفسيّ؛ فالحسّ الرفضويّ في الشوارع والفضاءات العامّة إنّما هو رحلة استشفائيّة على المستوى الوجدانيّ، وعندما نهتف للحرّيّة بكلّ ما أوتينا من غضب؛ فإنّنا نهتف باسم كلّ اللحظات الّتي انحشر فيها الكلام في المسافة الفاصلة بين اللسان والحنجرة بفعل القمع على أيّ مستوًى كان.